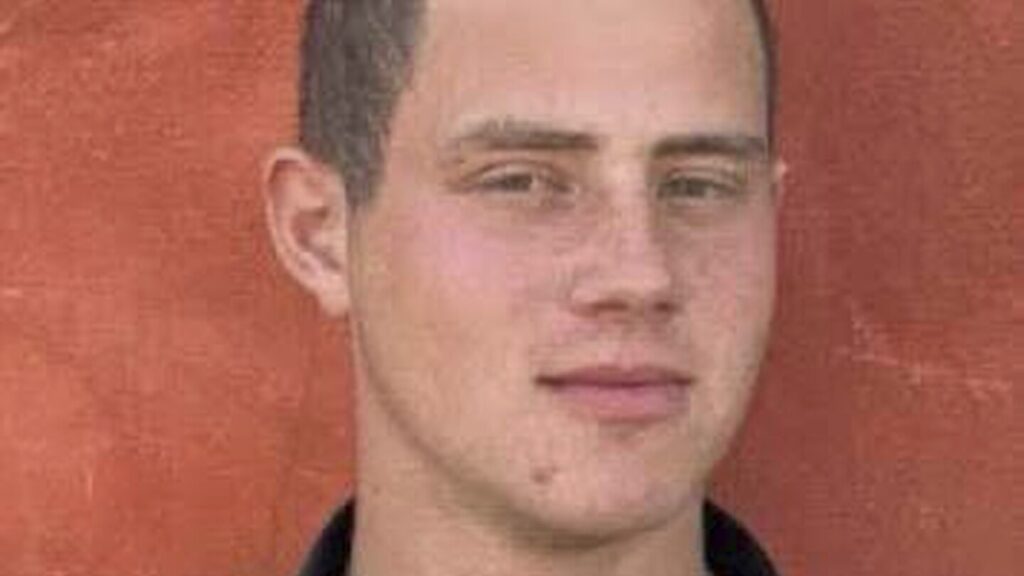لو كان محمد شكري حياً (1935 – 2003) لكان الآن في التسعين من العمر يتناول القهوة في «الكافيه دو باري» في طنجة، ويكتب فصلاً آخر من «الخبز الحافي» أو «الشطار»، أو تلك الملاحم القاسية من البؤس والعوز والقسوة، ونوم الليالي الجائعة في مقابر طنجة، يدخن أعقاب السجائر، السباسب.
جاء محمد شكري من بلاد «الريف» فقيراً لا يعرف قراءة الألف باء. وكان والده سكيراً، ينهال عليه وعلى أمه وجميع العائلة بالضرب. وعندما بكى مرة من جوعه أمام أمه، قالت له الأم: «اصبر قليلاً سوف نجد ما تأكله عندما نصل إلى طنجة».
في نواحٍ كثيرة، كانت المدينة تشبه الفتى القادم؛ فقد كانت خلال الحرب العالمية، وبعدها بقليل، ملاذ المشردين ورفاق السوء. وبُعيد الحرب، اكتشفها الكتَّاب والشعراء الأميركيون الذين يعيشون في باريس، فانتقلوا إلى الحياة في تراخيها وحرياتها.
سارا معاً نحو الحياة. هو، بدأ الدراسة وحصل على شهادة في الخامسة والعشرين، وطنجة بدأت تنمو وتتعظ. لكن المدينة على تراخيها لن تغفر بسهولة للكاتب الجديد تلك الواقعية الوجودية الفجة، ولن يتراجع الفتى البائس. والآن أصبح الكتَّاب الأميركيون الذين يعيشون في المدينة يترجمون أعماله. وتُرجمت «الخبز الحافي» إلى 39 لغة، بينما نقل أعماله إلى الفرنسية، الروائي المغربي الطاهر بن جلون.
هل كان شكري يعرف، أو يدرك، عندما وضع «الخبز الحافي» أنه يتجاوز في «واقعيته» كل شيء؟ هل كان يدرك ماذا يعني لقرائه أن والده في فورة غضب، ظل يضرب شقيقه الأصغر، إلى أن مات بين يديه؟
جميع أعمال محمد شكري جزء من سيرة ذاتية. من تشرد إلى تشرد، ينتهي به الأمر في السجن، وهناك، تبدأ حياته في التغير. يرى يوماً كتابة على
الجدار فيسأل رفيقاً أن يقرأها له. يقرأ الرفيق ويشرح: «إذا الشعب يوماً أراد الحياة… فلا بدّ أن يستجيب القدر». سوف تكون قصيدة أبي القاسم الشابي درس العمر. لكن حياة شكري تظل مغلقة بشيء من القسوة. ومات قبل أن يعتبر النقاد أن عمله أدب، وليس (أباحة). ونفضت طنجة عن نفسها سمعة الخطايا على أنواعها. ويوم غاب، أقيمت له جنازة المكرمين. وحمل النعشَ إلى مثواه ضباطٌ من رجال الدرك. وحضر وزير الثقافة ومحافظ المدينة. لقد رُفع الحظر عن شريد طنجة.
رابط المصدر