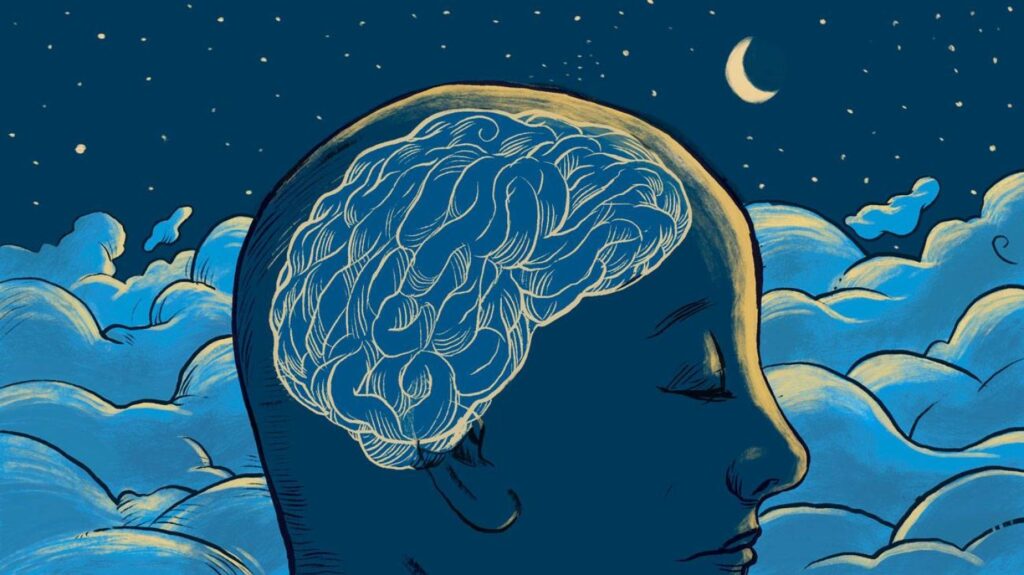لكنَّ مشكلتَنا مع قراءة ماضي «التشابكات» بين لبنان وإسرائيل… أنَّ أيَّ تفاؤل بتغيّر حقيقي وإيجابي في السياسة الإسرائيلية، خلال العقود الأخيرة، كان ينتهي بمزيد من التعنت والعدوانية.
الشواهد أكثر من أن تُعد وأن تُحصى، وأوضحها – بلا شك – الانهيار شبه الكامل لقوى الاعتدال الإسرائيلية المؤمنة بالحوار، مقابلَ التزايد المطّرد في نفوذ غُلاة الاستيطانيين الفاشيين والعنصريين «الترانسفيريين».
هؤلاء الغُلاة هم الذين يستقوي اليوم بهم شخصٌ مثل بنيامين نتنياهو، ليس فقط على خصومه السياسيين المدنيين… بل أيضاً حتى على المتحفّظين عن انتهازيته وممارساته داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.
ثم إنَّ الواقع المؤلم الذي نرى أمامنا، هو أن نتنياهو نجح – وينجح دائماً – في إضعاف أولئك المتحفّظين، عبر هروبه الدائم إلى الأمام، وإضافته مزيداً من الجبهات والأهداف الميدانية لكل مغامرة حربية يتعمّدها ويخوضها.
موضوع غزة، مثلاً، يبدو وكأنَّ الأحداثَ تجاوزته وسط صمت موجع وتواطؤ دولي على كل المستويات. وبينما تتسابق جمعيات المستوطنين على «تقاسم جلد الدُّب» التي تعتبر أنَّها اصطادته وانتهى الأمر، تُنشر إعلانات عقارية وقحة لوضع اليد على المناطق المُهجّر منها أهلها في القطاع المحتل!
أمَّا على «الجبهة الشمالية»، حيث تُقصف مدن لبنان وقُراه، وتحاول القوات الإسرائيلية في جنوبه إحداثَ اختراقات تمهّد لتغيير الحقائق الجغرافية، فإنَّ القلق يساور العقلاء من اللبنانيين من «أهداف إسرائيل المتحركة»…
اللبنانيون يتذكّرون جيداً ما حدث في قطاع غزة، حيث برّرت حكومة نتنياهو المجازر وعمليات التدمير والتهجير، بدايةً بـ«إنقاذ الرهائن» و«الدفاع عن النفس»، ثم بضرب البنية العسكرية لحركة «حماس»… وها نحن الآن وصلنا إلى التلويح العلني بالاستيطان. غير أنَّ المشكلة في لبنان تكمن بأربع «آفات» قاتلة بالكاد تعلّم منها اللبنانيون شيئاً.
– الآفة الأولى هي التشرذُم الفئوي، الذي حال منذ عقود عديدة دون صياغة هوية واحدة تنتج ولاءً واحداً لوطن واحد. وحالياً نلاحظ أن «مخطّطي الحروب» الإسرائيليين حريصون على استنهاض الحساسيات والمخاوف المتبادلة عبر تكثيف الاستهداف العسكري، وتسريع النزوح والتهجير من مناطق ذات هوية طائفية معينة، إلى مناطق أخرى… وطبعاً، من دون إسقاط احتمال تعمّد إثارة الاحتكاكات والاستفزازات في كيان هشٍّ سياسياً واجتماعياً.
– الآفة الثانية هي رهان مكوّنات هذا الكيان على «الخارج» هرباً من خيار التفاهم الداخلي، مع أنه في كل مرة تبيّن أن التكلفة باهظة، وربما كان ذلك التفاهم أجدى وأسلم. وللأسف، تكرّر هذا الرّهان العبثي منذ بلوَرة أول مشروع «هوية وطنية» تمحوَرت حول منطقة جبل لبنان في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
– الآفة الثالثة هي أنَّ القوى الموجودة في محيط الكيان – أو الوطن كما يفضل البعض – كانت ذات تأثير دائمٍ وقويٍّ عليه. فهو من ناحية ليس بجزيرة منعزلة، ومن ناحية ثانية كانت حدوده الإدارية دائماً عرضة للتبدّل مع ما يعنيه ذلك من تغيير المعادلات الديموغرافية.
– الآفة الرابعة أن لبنان عبر تاريخه الطويل، منذ أيام «المدن الدويلات» في العصور القديمة إلى وضعه اليوم كدولة مستقلة، كان في حالة تفاعل دائم بحري وبرّي مع قوى خارجية. وعبر العقود مرّت فوق أراضيه وسيطرت على بحره قوى عديدة آسيوية وأفريقية وأوروبية، واستمر النفوذ الأجنبي فيه وعليه حتى اليوم. من ثم، فإنَّ الوضع الحالي يحمل – في آن معاً – مخاوف وجودية خطرة وفرص إنقاذ ثمينة، إذا أحسن اللبنانيون التصرّف. وهنا أقصد… إذا ما تفاهموا فيما بينهم على القواسم المشتركة والأولويات المطلوبة، قبل أن يفقدوا نهائياً السيطرة على مقدّراتهم في «شرق أوسط» تتقلَّص فيه أدوارُ «اللاعبين الصغار»، وينشغل عن مصائر هؤلاء أصحاب القرار الدولي.
لقد علّمتنا حملة الانتخابات الأميركية، بالضبط، ما يعنيه انشغال واشنطن في شؤونها الخاصة، وبراعة بعض اللاعبين الإقليميين – تحديداً إسرائيل – في استغلال هذا الانشغال لإنجاز مشروعهم الخاص بتغيير شكل المنطقة.
وبطبيعة الحال، التساؤلات كثيرة في أوساط اللبنانيين، داخل وطنهم وفي كل المهاجر البعيدة والقريبة، عمّا يمكن أن يحصل. وهنا أزعم أنَّ نتيجة الانتخابات الأميركية، بعد أيام باتت معدودة، ستكون العاملَ الأهمَّ والأشدَّ تأثيراً على الاتجاه العام للأحداث.
قد يقول قائلٌ إنه لا فوارق تُذكر بين سياسات مرشحي الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي إزاءَ الشرق الأوسط، برغم تناقضها الواضح على الصعيد الداخلي الأميركي.
ربَّما يكون هذا الكلام قريباً من الحقيقة. لكن القريب من الحقيقة أيضاً أنَّنا، لبنانيين وفلسطينيين، عرباً ومسلمين، أضعفُ بكثير من إحداث التغيير المأمول داخل أروقة القرار في واشنطن.
نحن طارئونَ على مفاهيم «الدولة العميقة» هناك.
إنَّنا قليلو الإلمام بالثقافة السياسية وشبكة المصالح، ومتفرّقو الأهداف ومتعدّدو الأغراض، وذوو تركيزٍ مؤقتٍ ونَفَسٍ قصير لا يصلحان لبناء قاعدةٍ مصلحيةٍ متينة تستشرف الأحداثَ وتُجيد «تحويلها» لفائدتها.
لكل هذه الأسباب نرى أنَّنا أسرى ردّ الفعل وليس لدينا التخطيط المُسبق له، وفي حين نرى الساسةَ الصاعدين ينأون عنَّا ويتزلَّفون لخصومِنا… فهم يجرون خلفَنا بمجرّد «تقاعدهم»!!
رابط المصدر