المقريزي وذكراه الـ600.. رحلة إمام ومشوار مشروع علمي معماري غزير

<ب>بهذه الببابات عبّر الإمام المؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ/1442م) -في بمدخل كتابه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»- عن عميق انتمائه إلى وطنه مصر، وشديد احتفائه بنشأته في حواري مدينته القاهرة ودروبها، وعظيم فضل بلاده عليه في مختلف مراحل سيرته ومسيرته.
<ب>وبهذه الببابات تسفر كذلك عن طبيعة المقريزي وطريقته في الكتابة؛ فهو من نوعية العلماء الذي لا يشرعون في التدوين إلا إذا انعقدت صلة بينهم وبين ما يبحثون فيه ويكتبون عنه. ولعل في ذلك تكمن عبقريته لاتصاله الوثيق مع قضاياه البحثية وهمومه المعرفية، وفي الوقت نفسه لا يسمح لعاطفته -في الغالب- بأن تجور على الحقيقة وما تدفع بها من نتائج.
<ب>وفي الغالب ترغب هذه الصفوة من العلماء
في العزلة والانفراد مع كتبها كانت الطالبة تجد الأنس والراحة، وكانت حياة المقريزي العلمية مليئة بالمشاريع الكبيرة في منزله بحارة برجوان من حي الجمالية في القاهرة.
قد سبقت عزلة المقريزي -بأسبابها المختلفة- خبرته العريضة التي أكسبته صلة وثيقة بالحقيقة بكل جوانبها؛ من خلال مسيرته القضائية والإدارية والعلمية، وتجاربه وتأملاته التي جعلته “عمدة المؤرخين” كما وصفه أحد تلامذته المخلصين.
التاريخ بالنسبة للمقريزي لم يكن مجرد صفحات للتسلية أو السرد، بل كان مجالا للتأمل وديوانا للعبر ومخزنا للمواعظ؛ فكان وسيلة لتحسين الحياة ومواجهة اليأس بالاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذا ما قام به المقريزي في كتابه “إغاثة الأمة” حيث قدّم قصص المحن والجوع بهدف تحفيز القارئ وإزالة الوهم الذي يحيط بالمحن التي تمر بها المجتمعات، وتشجيعه على مراجعة دورات الشدة والرخاء في الدول عبر التاريخ، بهدف التخلص من اليأس وتقديم الحلول المناسبة.
كانت القاهرة التي عاش فيها المقريزي مدينة مظلمة بعد الانتعاش، ومنهارة بعد الحضور، وانهيار العواصم والمدن الكبرى لم يكن نتيجة ضربات جسيمة، بل كان نتيجة انهيار القيم الأخلاقية وتدهور البنية المجتمعية وتراجع النظام السياسي كما وصفه المقريزي.
كانت القاهرة في زمن المماليك عرضة للزوال، وعندما يعيش المؤرخ مثله في زمن الأزمات بسبب فشل وفساد الحكم، يكون تحليل الأسباب والمشاكل واضحا في كل كتاب يكتبه.
من خلال كتاباته، كان المقريزي يعبر عن تعددية الشخصيات المصرية، وكان يدرس تأثير الأقباط في التاريخ المصري قبل الإسلام وبعده، مما جعله مرجعا موثوقا للجميع للتعرف على تاريخهم.
باختصار، كان المقريزي من أبرز المؤرخين الذين درسوا تاريخ مصر بشمولية وعمق، مما جعله محط اهتمام للقراء والباحثين على حد سواء.
التصوير وتوثيقه بالتفصيل الشديد، مما جعله يفوق الآخرين -بين الباحثين- في تضمين هذا التاريخ المثير بالأفكار والتنظيمات والحوادث ضمن مسارات التاريخ الإسلامي العام، وخاصة تلك المتعلقة بمصر، ووضعه تحت أضواء النقاش العادل دون تحيز أو تحايلا على حساب الحقيقة.
بخصوص هذا التاريخ، تناولت الدراسة مسألة تتعلق بشخصية المقريزي وأسرته، وهي “نسبه الفاطمي”؛ فوفق هذه المقالة -استنادا إلى ما كتبه بنفسه- تبين أنه لم يقدم نفسه بوضوح كفاطمي، ولم يكشف عن تفاصيل كثيرة بشكل صريح حول أصوله البعيدة بعد الجد العاشر، وأن ادّعاء هذا التنسيب مرتبط بالرأي الذي كان يؤيده المقريزي والقاضي بثبوت نسب الفاطميين إلى آل البيت. على الرغم من ذلك، فإن المقالة تحتوي على تصحيح يعدل بعض ما أورده بعض العلماء في هذا السياق، من دون تجاهل أن الجد الذي نسبوا إليه لم يؤسس ذريةً بشكل قاطع؛ وفقا لما أكده المقريزي نفسه في أحد كتبه!!
تبقى نقطة أساسية تبرز من كتابات المقريزي فيما يتعلق بقضايا عصرنا الحديث؛ وهي تلك التي تكشف عن جذور التأثيرات التشريعية والقانونية الأجنبية التي تم تضمينها في البنية القضائية الإسلامية خلال عصر دولة المماليك في مصر والشام، مقدما ما يمكن اعتباره تاريخا نادرا لـ”علمنة القضاء” في وقت مبكر من تاريخنا، وتحليل فكري ثاقب يستحق الاستشارة في تحليل تأثيرات التشريعات الغربية المعاصرة على نظامنا القضائي، والتي تمر عبر المسارين التي تطرق إليهما المقريزي، وهما: القضاء المختلط والنخبة المنحازة للكائن الأجنبي!
تسعى هذه المقالة إلى سلط الضوء على أبرز جوانب حياة المقريزي -سواء كشخص أو كنص- في هذه اللحظة التاريخية التي نحتفل فيها بالذكرى الستمئة لرحيله، ليس لتقديم تقدير لشخصه أو لتوضيح فضله وإنما كإعادة الاعتبار لمدرسة متميزة في كتابة التاريخ وأسلوبها الفريد في “العبر والاستفادة”، والاستمداد من منهجه العلمي في “مساعدة الأمة” في لحظة تتشابك فيها أحزاننا بين أمسنا واليوم.. وتتطابق آمالنا بين اليوم والغد!!
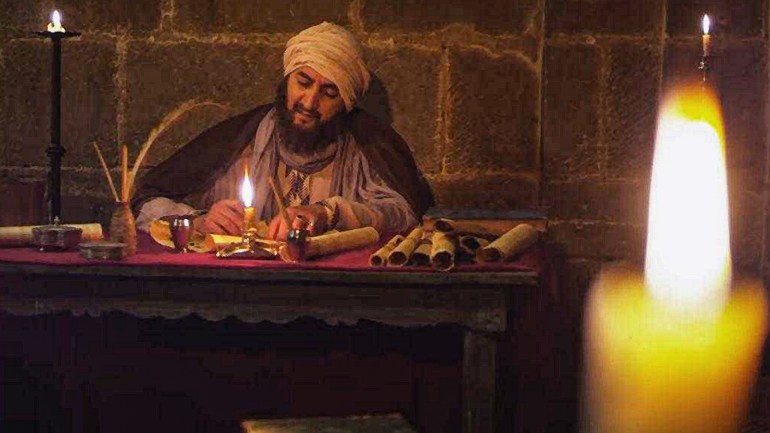
سيرة ذاتية
ولد أحمد بن علي المقريزي سنة 766هـ/1365م في حي برجوان الراقي في العاصمة القاهرة المملوكية، ونشأ في عائلة قدّمت سلسلة كاملة لنسبها -كما جاء في كتابه ‘السلوك‘- حيث قدم نفسه بقوله: “أحمد بن “علاء الدين علي بن محيي الدين عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد بن تميم المقريزي”.
وبخصوص أصل نسب “المقريزي” الفريدة التي اشتهر بها، يشير صديقه الوفي ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) في كتابه ‘المجمع المؤسس للمعجم المفهرس‘ إلى أنها “مشتقة من حي المقارزة في بعلبك، حيث نزل جَدُّه الأعلى: إبراهيم بن محمد”.
ويعود الفضل العلمي الذي اشتهرت به عائلة المقريزي إلى جده المحدث محيي الدين عبد القادر بن محمد (ت 733هـ/1333م)، الذي كان رائدا في مجال علم الحديث وقد شق طريقه من بعلبك إلى دمشق لتصبح هذه الأخيرة مقراً للعائلة، وقد كرّمه ابن حجر العسقلاني في ‘الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة‘ كواحد من أهم العلماء في ذلك الوقت.
شق ابنه الطريق العلمية بنفس النجاح ليصبح الفقيه الحنبلي المحدِّث المرموق…
المعلومات الواردة حول الشخصية التاريخية – علاء الدين علي بن عبد القادر (المتوفى 786هـ/1384م) – تفيد بأنه ولد وترعرع في دمشق وحصل على تعليمه هناك، لكنه انتقل إلى القاهرة واستقر بها وعمل فيها لبعض الحكام حسب ما ذكره ابن حجر في كتاب “الدرر الكامنة”. أما تقرير المقريزي الابن في كتابه “السلوك”، فذكر أن والده كان يشغل مواقع عدة وكانت له خبرة في كتابة النصوص والحسابات، مع دين قوي وعقل ناضج!
فيما يتعلق بسيرة علاء الدين المقريزي الأب، فإن أكثر المعلومات الشائعة عنه هي أنه التقى بالإمام شمس الدين ابن الصائغ خلال إقامته في القاهرة. الإمام شمس الدين كان قاضيًا ومفتيًا وعالمًا في الفقه والأدب بحسب ما سجله سبطه المقريزي في كتابه “السلوك”. يروي المقريزي أن جده تولى منصب إفتاء دار العدل، كما وصفه بأنه كان شخصًا مرموقًا في الشؤون الدينية والدنيوية!
عقد علاء الدين المقريزي قرانه على ابنة الإمام شمس الدين ابن الصائغ في عام 765هـ/1364م. كانت الزوجة مشهورة بعلمها وثقافتها الأدبية التي لا تقل عن السيدات المثقفات في التاريخ الإسلامي. ووصفها ابن حجر بأنها كانت امرأة عاقلة وفاضلة في الدين، وقدم ابنها تقي الدين ترجمة جيدة لها ونقل بعض قصائدها.
قام ابنها بترجمتها كما ذكره ابن حجر في كتابه “درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة”، حيث وصفها بأنها كانت فريدة من نوعها في زمانها! وأورد المقريزي أيضًا بعض حكاياتها من والدها في كتابه “السلوك”، حيث قال: “سمعت أمي أسماء بنت محمد بن عبد الرحمن الحنفية…”.
تولى الوالدان رعاية التعليم والتربية لابنهما المقريزي في منزل جده في حارة برجوان بمنطقة الجمالية في مدينة القاهرة. وكان جدّه لأمه شخصية معروفة بالفضل والمهارة في الكتابة والنثر، وكان يتعامل مع الحكام والشخصيات المؤثرة بالدولة كثيرًا كما ذكره ابن حجر في كتابه “إنباء الغمر”. كما وأشار إلى أنه كان يدرس بانتظام ويتعامل مع رؤساء الدولة.

موهبة مبكرة
يبدو أن الكتب التي كتبها جده -والتي كانت تتضمن مواضيع لغوية- كانت من أولى الأشياء التي دراستها المقريزي في بداية رحلته التعليمية. في كتابه “المنهل الصافي”، ذكر تلميذه المخلص المؤرخ ابن تغري بردي – الذي توجه بالتفسير بعد فترة طويلة لأسباب وردت في الكتاب – أنه كان يتميز بفهم مذهب الحنفية كما جده، ثم اعتنق المذهب الشافعي وتألق في كتابة الأعمال النافعة وأصبح مؤرخًا مطولبًا.
وعلى الرغم من أن ابن تغري بردي – من بين أبرز علماء المماليك – لم يكشف عن سبب تحول معلمه المقريزي من مذهب جده الحنفي إلى الشافعي، إلا أن ذلك يعكس الموهبة المبكرة والاستقلال العلمي لدى المقريزي. وأرجع صديقه ابن حجر ذلك إلى سببين: شخصي وموضوعي. وفي كتابه “المجمع المؤسس”، وصف تقي الدين بأنه “تحوّل إلى المذهب الشافعي بعد أن استفاق”، وذكر أيضًا في كتابه “الدرر الكامنة” أنه كان “من المحبين لأهل السنة ويميل إلى الحديث وممارسته مما جعله يقترب من [مذهب] الظاهر”، وهنا يشير إلى “المذهب الظاهري” في الفقه.
رغم انتماء المقريزي للمذهب الظاهري، إلا أنه قد استوت نزعته الفكرية قبل انتمائه للمذهب الشافعي. وتذكرنا هذه الحالة بالعلاقة الوطيدة بين المذهبين، حيث كان انتماء لأحدهما يمكن أحيانًا من اعتناق الآخر، كما حدث مع العلماء المميزين من رجال الظاهرية وتأثروا بشدة بأعمال المقريزي، مثل الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري (المتوفى 456هـ/1065م) وأبو حيان الغرناطي (المتوفى 745هـ/1344م)، حيث كان الأول شافعيًا قبل أن ينتمي للظاهرية والثاني كان ظاهريًا قبل اعتناقه المذهب الشافعي!!
في كتابه “الضوء اللامع”، قدّر الإمام السخاوي (المتوفى 902هـ/1494م) العمر الذي اعتنق فيه المقريزي المذهب الشافعي بعد وفاة والده في سنة ست وثمانين (= 786هـ/1384م)، حيث كان في سن العشرين، واعتمد على المذهب الشافعي بشكل نهائي.
وعلى الرغم
بعد أن أذن زملاء المقريزي وتلامذته بانتقاله إلى الشافعية؛ يعتبر المؤرخ عبد الباسط ابن شاهين المَلَطي (ت 920هـ/1514م) أنه كان ينتمي إلى الشافعية والظاهرية في الانتماء المذهبي. وقد وصفه في كتابه ‘نيل الأمل’ بأنه “الحنفي ثم الشافعي، وربما الظاهري حسب ما يقال عنه وما يظهر من عباراته وإشاراته”!! كما لاحظ الباحث الألماني رودولف شتروتمان (ت 1380هـ/1960م) انحيازه للظاهرية في كتبه بشكل عام، وصرح بأن “المقريزي يكتب بروح ظاهرية”؛ كما ورد في كتابه المشار إليه.
قام مترجمو المقريزي بربط اهتمامه بعلم الحديث وانحيازه للمذهب الظاهري؛ بالنظر إلى انتقال آرائه الفقهية لهذا المذهب وإشادته برجالاته في عصره، وأيضا تضمنت كتبه تقديرًا واضحًا لسيرة الإمام ابن تيمية (ت 728هـ/1328م)، حتى اختار لنفسه الكنية “أبو العباس” واللقب العلمي “تقي الدين”. وأبدى المقريزي حزنه على ضياع كتب الإمام ابن تيمية كونه “وريث علم النبوة”، وأشار إلى أن “معظم مؤلفات ابن تيمية قد حرِقت، ولا يوجد سوى قليل منها بيد الناس، ولا قوة إلا بالله”!!
تُشير كل هذه العناصر إلى أن اختياره التحول إلى الشافعية كان مرتبطًا بميوله نحو المذهب الظاهري. ولا بد من ملاحظة أن المذهب الشافعي يُعرف بالمساهمة في توحيد مذهبي أهل النظر (الحنفي) وأهل الأثر (الحنبلي)، وربما كان المقريزي يُفضل اعتماد مذهب وسطي لا يميل فيه إلى أحد فرعي عائلته! وعلى الرغم من ذلك، سجل تلميذه ابن تغري بردي أنه “كان يتميز بتعصبه للسادة الحنفية وغيرهم نظرًا لانحيازه لمذهب الظاهر”!!
إلى جانب العوامل الأخرى المؤثرة في “التحول المذهبي” الذي انتشر بين العلماء في عهد المقريزي، يجب الانتباه إلى طموحه للحصول على مناصب دينية كبيرة في مصر والشام، حيث كان علماء الشافعية يحظون بالأولوية في التوظيف خلال فترات الدولة الأيوبية والمملوكية.
على الرغم من ذلك، يبدو أن المقريزي لم يتخل عن دعم أهل الحديث والأثر حتى في كتبه التي تعكس اعتزازه بمذهب الظاهر، على الرغم من عدم تمييزه بنفسه على الرغم من أنه “لم يعترف به”؛ حسبما ذكر السخاوي والذي قام بتغيير عبارة ابن حجر في هذا السياق، حيث قال إن المقريزي “كان متهمًا باتباع مذهب ابن حزم ولكن لم يُعرَف به”! ويبدو أن المقريزي كان يخفي علاقته بالظاهرية -التي لا يحبها أهلها- كما كان يخفي ارتباطه بالفاطميين، مع الاحتفاظ بالدوافع واضحة وراء هذه المواقف!
بصفة عامة؛ فإن هذه القصة -التي شكلت شخصية المقريزي- يُمكن التعرف عليها من خلال شخصيات أخرى قدمها بنفسه، ومن بظهوره الواضح في الإمام أبو حيان الغرناطي الذي وصفه المقريزي في كتابه ‘المقفَّى الكبير’ بأنه “ظاهري المذهب، محبٌ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تنحى إلى مذهب الإمام الشافعي، محترم لتقي الدين أحمد بن تيمية ومتبع لرأيه”!!
إن هذه الوصف المعرفي والمذهبي البنيوي يتناسب تماما -في الحقيقة- مع شخصية المقريزي نفسه، خاصة مع تأثره بأبو حيان الغرناطي الذي كان معلمه ابن الصايغ، وعلى ما يبدو كان المقريزي أيضا متأثرًا بكتاب لأبي حيان تضمن سرد لمؤلفاته، وهو كتاب: “الأنور الأجلي في اختصار «المُحَلّى»” في فقه الظاهرية لابن حزم”.

انتماء فاطمي؟
يشير هذا الاصطلاح إلى الانتماء العائلي الضيق للمقريزي؛ أما الانتماء النسبي الأبعد والأوسع الذي يرتبط به المؤرخ هو انتماؤه إلى البيت الهاشمي من السلالة الفاطمية الشيعية التي حكمت مصر لفترات طويلة، على الرغم من أن “علماء السنة بشكل عام لا يميلون إلى الفاطميين، ونادرًا ما نجد بينهم -باستثناء المقريزي وابن خلدون– من يعترف بصحة نسبتهم إلى العلويين”؛ حسبما أشار المستشرق جورج مارسيه في بحثه حول الفاطميين.
وعلى الرغم من أن المقريزي لم يذكر بوضوح انتماؤه إلى الفاطميين، ولم يُقدم أي معلومات دقيقة حول أصوله البعيدة، وكيفية توريث عائلته للعلم عبر الأجيال، فإنه لم يتناول هذه الجوانب في معظم كتبه.
نقلا عن بعض الروايات الجدّ بن تميم؛ فقد سجل بعض الثقات المُعاصرين له الذين ذكروا قصة نسبه، وأشاروا إلى أن “تميم بن المعزّ لدين الله القائم بالمملكة الفاطمية” هو جدّه من العائلة. ويُعتبر المعز لدين الله أحد خلفاء الدولة الفاطمية وأولهم في مصر، حيث أسس عاصمتهم الفاطمية القاهرة. يُحترم المعز لدين الله كثيرًا في كتب المقريزي حيث وُصف في كتاب “السلوك” بلقب “أمير المؤمنين الإمام المعز لدين الله أبو تميم معد الفاطميين”.
وبالنسبة للمؤرخين، هناك تنوع في وجهات النظر حول انتساب المقريزي للفاطميين، فبعضهم يؤكد على هذا الارتباط بينما يُظهر البعض الآخر تحفظاً. الحافظ ابن حجر العسقلاني من الفريق الأول الذي أشار إلى نسبه إلى تميم بن المعز باني القاهرة، ولكنه اعتذر عن إثبات هذه النسبة في كتبه بزعم أنه لم يُظهرها إلا للمقربين منه.
بعض المترجمين وُصِفوا المقريزي بلقب “العُبَيْدي” مشيرين إلى عُبيد الله المهدي، مؤسس الدولة الفاطمية في الغرب الإسلامي. وقد استخدم بعض النُفاة هذا اللقب للشكوك في صحة النسب العلوي للفاطميين. ورغم اتهامات بعض النقاد للمقريزي بالانحياز إلى الفاطميين، إلا أن التأكيد على نسبه إلى عُبيد الله المهدي لم يتوقف عند أي فريق.
يظهر بوضوح أن المؤرخين المقرّبين جدًا من المقريزي، مثل ابن حجر وابن تَغْري بَرْدي، اكتفوا بذكر الترجمة دون أدنى إلمام بنسبه العائلية. ولم يُشيرا في ترجماتهما إلى أي انحياز عائلي للمقريزي.
ومن الجدير بالذكر أن ابن تَغْري بَرْدي تجنب الحديث عن موضوع النسب الفاطمي عندما ورد ذكره في كتابه “المنهل الصافي”، إلا أنه ذُكر ذلك في كتابه اللاحق “النجوم الزاهرة” حيث ذكر أن ناصر الدين محمد أخبره بالنسب لعُبيد الله المهدي.
وفي هذا السياق، يُذكر أنه كان من المعروف أن المقريزي كان يُحتفظ بنسبه الفاطمي ولم يُفصح عنه إلا أمام الأشخاص الذين يثق بهم. وتظهر شهادة ابن حجر أنه عرض على المقريزي مستندات تثبت نسبه إلى تميم بن المعز لدين الله، وكان يقوم بتعديل المعلومات التي تتعلق بذلك.
بسبب تأكيدها تفرد المُقَفَّي الكبير بأن هذا الجَد المُزعوم كان ليس له نسل ولا ولد، بشهادة والده المُعَزّ.
إذ “شاهد المُعَزّ على خلع تميم من [ولاية] العهد بسبب عدم تركه ذرية بالمطلق!! وقد تُوفي تميم وهو يبلغ 38 عامًا كما أفاد قاضي القضاة شمس الدين، ابن خلّكان (ت 681هـ/1282م) في ترجمته له في كتاب ‘وفيات الأعيان‘. والمُذهل هو عدم انتباه المُترجِمين للمُقَفَّي -سواء القُدماء أو المُعاصِرين- لهذا النص الذي أشار إليه المُقَفَّي نفسه في إحدى كتبه التراجمية، والذي يُنفي بوضوح انتسابه لتميم بن المُعَز كما جاء في قول صديقه ابن حجر عن مركزه وكرامته.
وهناك وجهة نظر أخرى في نسب المُقريزي نقلها المؤرخ موفّق الدين سبط ابن العجمي (ت 884هـ/1479م) -في ‘كنوز الذهب في تاريخ حلب‘- استنادًا إلى أحد علماء عصره، الذي قال إنه “اكتشف في كتاب قديم نسبةَ الخلفاء العلويين (= الفاطميين) وأبنائهم وذريتهم رجلًا رجلًا وامرأةً امرأةً”، وأنه كان من بين تلك النسيجية الأعلى للمُقريزي -والتي هو عبد الصمد بن تميم- نسبه إلى ابن للخليفة الفاطمي المُعَز لدين الله غير “تميم”؛ حيث كان نسبه يظهر على النحو التالي: “عبد الصمد بن تميم بن علي بن عَقيل بن المعز مَعَدّ بن المنصور إسماعيل بن القاسم بن المهدي عُبيد الله”.
فإذا كانت هذه القصة صحيحة -فإنها تصحح النقيض الظاهر بين قصة ابن حجر عن انتساب المُقريزي لتميم بن المعز، وتصريح المُقريزي الذي يُنفي وجود أي تبعة له من الأساس!!
بالنسبة للبديل التوفيقي، فهناك احتمالان: الأول هو أن يكون النسب الفاطمي صحيحًا وأن المُقريزي لم يُؤكد هذه القصة التي وصلته من أبيه بأي بحث تاريخي أو استكشاف لسبب متعلق بطبيعة زمنه وظروفه، خاصة أن معظم علماء السنة يُلغون دحض أصل النسب العلوي للفاطميين، ولو قام المُقريزي بتأكيد انتمائه لهم، فسيعرض موقعه الاجتماعي وربما سلامته الشخصية للخطر.
الاحتمال الثاني هو أنه “غارق في ذكر إنجازات سلافه” كما وصف الإمام بدر الدين الشوكاني (ت 1250هـ/1834م) في كتابه ‘البدر الطالع بمحاسن مَنْ بَعْد القرن السابع‘، حيث وقع في حب تلك القصة التي سمعها من والده في جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي (ت بعد 411هـ/1021م)، وشعر بأهمية ارتباطه بالعائلة النبوية بسبب ما تعنيه من شرف عائلي كبير، خصوصًا أن المُقريزي كان دائمًا متفوقًا في كتاباته حول آل البيت وأخبارهم، بل قام بتخصيص بعض من كتاباته لهم كـ: «إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والحفدة والمتاع» و«معرفة ما يجب لأهل البيت النبوي على من عداهم»، وبالتأكيد كان سيكون سعيدًا بذلك “الانتساب” حتى لو كان غير موثوق به!
ربما كان هذا “الارتباط” هو الدافع الرئيسي وراء كتابة المُقريزي لتلك الأعمال الوافرة والفريدة عن تاريخ الفاطميين، حيث حظي عصرهم في مصر بصفة خاصة بكتابة المُقريزي المُوسعة حولهم، وبالأخص في كتابه «اتعاظ الحنفاء» الذي نجح به في إدراج الفاطميين (كنوعٍ من الدعوة والدولة) في سياق التاريخ الإسلامي بشكل لم يحدث من قبل -سواء من حيث المنهجية أو العمق أو التحليل- في السجلات التاريخية الإسلامية السنية، باستثناء تجريبة ذلك التضمين عند شيخه ابن خلدون حينما قدم -في الجزء الرابع من تاريخه- ملخصًا تاريخيًا عن الدولة الفاطمية ضمن تقديمه للدول الإسلامية. ويبدو أن المُقريزي وشيخه أرادا من خلال هذا التضمين أن يُعوِّضا عن فشلهما في إدماج الفاطميين نسبيًا في السلالة الهاشمية!!
ويجب أن نذكر أن نجاح المُقريزي في “تطبيع” تاريخ الفاطميين ضمن السياق السُني لم يحدث في أي وقت من أوقاتهم، وهو ما أكده أحد أبرز مؤرخي الإسماعيلية المعاصرين الأكاديمي الإيراني الدكتور فرهاد دفتري الذي قال -في كتابه ‘الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم‘- أن المقريزي “زود بأكثر الروايات الشامِلة حول الفاطميين في عدد من كُتُبه”، وبفضل أعماله “أصبحت الفترة الفاطمية من أفضل الفترات توثيقًا في التاريخ الإسلامي”.
ما يُعزز تميز مساهمة المُقريزي هذه في تأليف تاريخ الفاطميين؛ هو أنه يُعتبر أحد الأعمال التاريخية الرئيسية منذ تأليف كتاب «افتتاح الدعوة» لمؤسس الفقه الإسماعيلي وقاضي قضاة الدولة الفاطمية أبي حنيفة النعمان بن محمد (ت 363هـ/974م)، الذي قال دفتري إنه “أقدم عمل تاريخي معروف في الأدب الإسماعيلي، ويشمل الخلفية التي أدت إلى تأسيس الخلافة الإسماعيلية”.
الأمر مُفيد إذا كانت كتابات الفاطميين عن تاريخهم قليلة جدًا بحيث “لم تكن هناك سوى كتابة واحدة لعمل تاريخي إسماعيلي خلال قرون العصور الوسطى المتأخرة، وهي «عيون الأخبار» لإدريس عماد الدين (ت 872هـ/1468م) من الطَّيِّبية (= الفرقة التي تنتمي إليها من الدعوة الفاطمية) في القرن التاسع عشر في اليمن”؛ وفقًا لدفتري.
كما وصفت مفكرتي -في ‘معجم تاريخ الإسماعيليين‘- كتابَ «اتّعاظ الحنفاء» للمقريزي بأنه “سجل تاريخي شامل عن الأسرة الفاطمية الملكية…، ويعد أمتع التوثيقات للفاطميين من تأليف كاتب يتبع المذهب السني، كان يُؤكد انتسابه إلى الفاطميين”!
إذا كانت الجملة الأخيرة لمفكرتي توحي بأنها تبرير لـ”حيادية” المقريزي في تاريخه عن الفاطميين؛ إذاً الإمام الشوكاني سبقه في ربط ذلك الانتساب وتعمق المقريزي في تاريخ الفاطميين والنَفَس الغريب الذي تعامل معه؛ حيث قال إن ادعاء انتسابه إلى الفاطميين كان يُسهل على المقريزي “نشر تاريخهم الجيد وتقديمهم بصورة جيدة والإشادة بإنجازاتهم”!
ويتوافق مع هذا المنطق الإمامُ ابن حجر الذي اعتبر أن هذا الانتماء هو سبب تقوية علاقة المقريزي بمعلمه ابن خلدون؛ حيث قال عنه في ‘رفع الإصر عن قضاة مصر‘: “والغريب أن مؤلِّفنا المقريزي كان يشد على تقدير ابن خلدون نظرًا لاعتباره أصل بني عبيد -الذي كانوا حكام مصر واشتهروا بـ«الفاطميين»- إلى عليّ، ويخالف آراء الآخرين في هذا الأمر، وينبذ ما يرويه الأئمة في النيل من نسبهم ويقول: إنهم قد كتبوا ذلك الموقع احترامًا للخليفة العباسي. وكان مؤلِّفنا من المدافعين عن الفاطميين فأحب ابن خلدون نظرًا لتأكيد نسبتهم”! ومع هذا، يشهد ابن حجر -في ‘الدرر الكامنة‘- لصديقه المقريزي بأنه كان “من محبي أهل السنة يميل نحو الحديث وتطبيقه”، وهو ما ينفي أية نية مُشبوهة في كتاباته عن الفاطميين.
وظائف فائقة
وفي بداية حياته، اتَّبع المقريزي طريقَ الوظائف الرسمية تأسيًا بوالده، وهو اتجاه شائع في مصر حيث كانت أُسر الطبقة الوسطى في القاهرة تميل نحو العمل الحكومي والالتحاق بالوظائف الرسمية ذات الدخل الثابت، عوضًا عن أي حرفة أو صناعة أو عمل حرّ، واختار المقريزي الوظيفة على أن يختار العمل الحر، وتمسّك بمسار والده في عمله الذي نمّا على إثر تعليمه وتكوينه الأكاديمي.
كانت وظائف المقريزي تتبع الفئات العليا في الإدارة المملوكية، حتى أنه تولى جميع المناصب الكبيرة الدينية البارزة في عصره (القضاة والحسبة والخطباء) باستثناء وظيفة الفتوى الرسمية. وربما تظهر هذه التنوّع في الوظائف البارزة صحة قول تلميذه ابن تّغْري بردي -في ‘المنهل الصافي‘- أنه كان “محترمًا في الولاية”، أي في مختلف فترات حكم السلاطين المماليك لمصر.
وكانت علاقة المقريزي أولا بـ”أهل الحكم” -كما وصفهم- من خلال علاقته بالسلطان الشركسي الظاهر برقوق (رحمه الله، ت 801هـ/1398م)، حتى وُكِّل بتولي الحكم، وكتابة التوقيع [في ديوان الإنشاء]، وتولى الحسبة في القاهرة؛ وفقًا للسخاوي.
وظيفة “النيابة في الحكم” تُعد أحد المسؤوليات في قطاع القضاء، وربما كانت مرتبطة بتولي منصب قاضي القضاة في “دار العدل” أو ديوان المظالم المشابه لمنظومة “مجلس الدولة” القضائية الحالية، وكانت تُخصص لفصل النزاعات حول تصرفات الحكَّام ومشكلات الإجراءات الرسمية والمنازعات الإدارية.
وفي كتابه ‘المواعظ والاعتبار‘، وصف المقريزي هذا الديوان العالي الشأن، إذ قال: “كانت العادة أن يجلس السلطان في هذا الديوان (= ديوان المظالم).. [فـ]ـيجلس قضاة القضاة من الطوائف الأربعة عن يمينه، وأكبرهم الشافعي، الذي يأتي بعد السلطان، ثم إلى جانب الشافعي الحنفي، ثم المالكي، ثم الحنبلي، وإلى جانب الحنبلي الوكيل عن بيت المال، ثم المسؤول عن الحسبة في القاهرة. ويجلس على يسار السلطان كاتب السر. وإذا كان الوزير من أرباب الحرب (= الأمراء) كان واقفًا في مكانه مع بقية أرباب الوظائف، وإذا كان نائب السلطنة فإنه يقف مع أرباب الوظائف، وتقف خلف السلطان صفوف من الحراس وأمناء الخزينة والجوامع”، وهذه جميعها ترتيبات رسمية لخدمة السلطان وتكريمه وحمايته الشخصية.
أما وظيفة “التوقيع السلطاني”؛ فقد يكون المقريزي بدأ أعمالها وهو شاب، وقد أشار إلى ذلك في ‘المواعظ والاعتبار‘: “وأنا شهدتها مع قاضي بدر الدين محمد بن فضل الله العمري (رحمه الله، ت بعد 792هـ/1390م) خلال توليي المهام الرسمية…، ثم تلاشت سلطنة الظاهر برقوق فأصبحت الأمور مضطربة، بما في ذلك قضية ديوان الإنشاء في القلعة” التي كانت موقعًا للسلطان على مستوى العمل والإقامة.
أما ولاية الحسبة؛ فهي منصب شريف الرتبة وشامل الصلاحيات والاختصاصات، وأوضح المقريزي أهمية وظيفة الحسبة بتأكيده على أن “من يُعيَّن فيها يجب أن يكون من أفراد المسلمين وشخصيات محترمة لأن الخدمة لطبيعتها دينية”. إنها تشتمل -في العديد من صلاحياتها- على مزيج من أعوان
تتعلق هذه المقالة بالحروف والحِرَف، والمهن ونقاباتها، والتجار، وبالتالي كان المحاسب يمتلك معرفة واسعة بتفاصيل تؤثر في الحياة العامة.
في كتابه “السلوك”، يحدد المقريزي بدقة تاريخ توليه لهذا المنصب لأول مرة، حيث يقول: “في الحادي عشر من رجب سنة 801هـ/1398م: استقرّ كاتبُه أحمد بن علي المقريزي في حسبة القاهرة والوجه البحري بدلاً من شمس الدين محمد المخانسي (الصعيدي المتوفى بعد 801هـ/1398م)”.
ورغم أن المقريزي تم عزله من وظيفته هذه بعد حوالي أربعة أشهر من توليها، إلا أن ابن تَغْري بَرْدي يذكر في كتابه “النجوم الزاهرة” أن الإمام بدر الدين العيني تولى “حسبة القاهرة في بداية ذي الحجة من السنة (= 801هـ/1398م) بسفارة (= وساطة)… الأمراء بدلاً من الشيخ تقي الدين أحمد المقريزي، ومنذ ذلك الحين بدأت العداوة تنمو بينهما حتى وفاتهما”!!
ومع هذا، عاد المقريزي مرة أخرى إلى الحسبة في عام 802هـ/1399م، ثم تم عزله منها مجدداً، ويذكر المؤرخ ابن شاهين المَلَطي في كتابه “الروض الباسم” بأنه عاد إلى الحسبة بعد ذلك مرات عدة في تواريخ مختلفة لم يحددها المَلَطي، ولكن يمكن تقديرها تقريباً بسنتي 809هـ/1406م و841هـ/1437م.
ونظراً لتولي المقريزي مهاماً عديدة ولفترة زمنية طويلة في مجال الحسبة، ازدادت علاقته بتفاصيل الحياة اليومية والمجتمعية، واكتسب تجارب وخبرات واسعة من تفاعله مع القوى والمؤسسات الفاعلة في المشهد الاجتماعي والسياسي والإداري والحضري. وقُدم تلك الخبرات له دعماً كبيراً في التفكير والرصد والتحليل والتأريخ بأسلوب متنوع وغني كما يظهر واضحاً في كتاباته وأعماله.
بالإضافة إلى ذلك، كان له إسهامات متعددة في المجال العلمي سواء من خلال التدريس أو الإدارة؛ فقد ذكر السخاوي أنه شغل مناصب مختلفة في جوامع عمرو بن العاص ومدرسة حسن وجامع الحاكم بالإضافة إلى تدريسه للحديث بالمؤيدية التابعة لمدرسة الشافعيين في القاهرة.
بالإضافة إلى وظائفه الدينية في القاهرة، زار المقريزي بلاد الشام واستقر في دمشق وتولى إدارة نظر قلانسي وبيمارستان النوري، فضلاً عن تعيينه للقاضي الشافعي وتدريس العلوم في مدارس الأشرفية، الإقبالية وغيرها.
بعد وفاة السلطان برقوق، زادت علاقة المقريزي بابنه وخليفته في السلطنة الناصرية فَرَج حتى دخل دمشق معـ[ـه] في عام 810هـ/1407م، ورفض تولّي منصب قاضي دمشق مراراً وتكراراً وفقاً لما ورد عن السخاوي.
رفض المقريزي تولي منصب قاضي دمشق يمكن تفسيره بأنه كان يطمح للحصول على هذا المنصب في القاهرة أو أنه يفضل عدم توليه نتيجة لاعتقاده أن العديد من العلماء يجدون صعوبة في قبول مناصب قضاء من البداية، أو يفضلون عدم الاستمرار فيه بعد تجربته. في جميع المناصب التي عُهدت إليه، كان معروفاً بالنزاهة في الإدارة والتسيير، ولهذا كُ praised في سلوكه العام”، حسب السخاوي.
واستمرت حياة المقريزي المهنية حتى عام 841هـ/1437م وبعد ذلك تخلّى عن تمارس المناصب الرسمية وأمضى الأعوام الأربعة الأخيرة من عمره “منعزلا في بيته، مكرسا وقته للعبادة والانعزال، نادراً ما كان يخرج إلا للضرورة”، وفقاً لما ذكره ابن تَغْري بردي في كتابه “المنهل الصافي”.
ابن تَغْري بردي يروي أن شيخه “ظل يستمر في حفظ الوقائع والتاريخ إلى أن توفي يوم الخميس السادس عشر من شهر رمضان عام خمس وأربعين وثمانمئة (845هـ/1442م)، ودُفن في اليوم التالي بمقبرة الصوفية خارج باب النصر في القاهرة”.
ويقدم دليلاً على استمرار شيخه في نشاطه العلمي حتى لحظة وفاته بقوله: “سمعت أنا في أربع جلسات كتاب «فضل الخيل» للحافظ شرف الدين الدمياطي المتوفى 705هـ/1305م) من قبل الحافظ قطب الدين الخيضٍري في سَلْخ شعبان سنة خمس وأربعين وثمانمئة (845هـ/1442م)… بحارة بَرْجَوَان على الشيخ الإمام العلامة المحدث تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي الشافعي”.
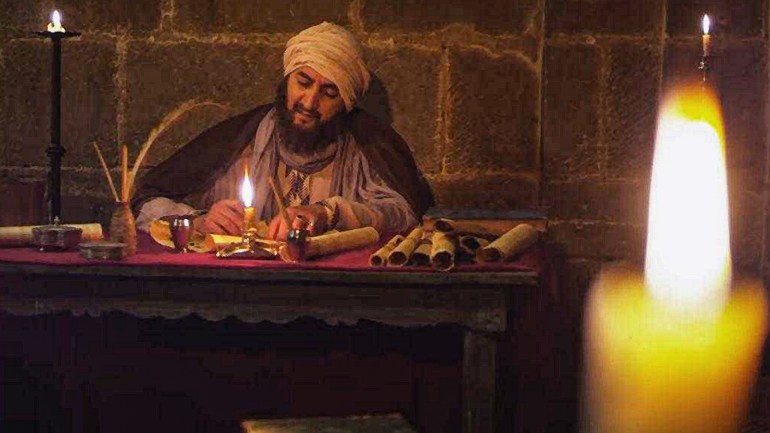
موسوعية المعرفة
اُمتيزت شخصية المقريزي بـ”محاسن متعددة” وفقاً لتلميذه ابن تَغْري بَرْدي في كتابه “المنهل الصافي”؛ إذ كان -على الصعيد الشخصي-
ذات مزاج معتدل، تبدو لنا سهلة كما قال “الاختيار يُظهر من يكون الإنسان” في عبارة السخاوي التي تشير إلى انشغاله بالكتابة عن أحداث وسير ذاتية. حيث أشار إلى أنه كان مهتمًا بشدة بالتاريخ حتى أنه كان يحفظ منه الكثير.
ودليل على شهرته واسعة الانتشار في كتب التاريخ، لقبه تلميذه المؤرخ ابن تغري باردي بأنه “استمر ذكره في الساحة العلمية بعد وفاته وصار يُفضل عليه في مجال التأريخ وغيره. لذا قدم السخاوي تقييما شاملا لفهم التاريخ عند المقريزي الذي كان يحسن جلبه، إذ كان يشير إلى انه “كان عميق الدراية بالأحداث القديمة في عهد الجاهلية والدولة الإسلامية ومعرفة الأفراد والأسماء والتحقق [لرواة الحديث] والمراتب والسير، وغير ذلك من أسرار التاريخ وفضائله؛ لكنه كان غير ماهر في جانب معين”!!
ولكن، يبدو لنا أن قوله “لكنه كان غير ماهر في جانب معين” يأتي في إطار تعليقات السخاوي التي تكون غير عادلة أحيانًا تجاه الأشخاص الذين يُشرفون على ترجمتها؛ ولذلك يعتبر هذا التعليق ليس بالجديد على سجلات هذا الإمام في تقديم التقاصيل – في كثير من الأحيان- في تراجمه حتى للشخصيات المرموقة، حيث وجَّه بدر الدين الشوكاني -في كتابه “البدر الطالع بمحاسن مَنْ بَعد القرن السابع”- اتهامات للمقريزي قُلَّع عن الصواب ثم قام بالتعليق قائلاً: “وإن جَحَدَهُ السخاويُّ فذلك دَأْبُه في غالب أعيان معاصريه”!!
وكان طرح المقريزي لموضوعات التاريخ يحظى بإعجاب أصدقائه وجلسائه، فكان كلامه -وفقًا لعبارة ابن تغري باردي- شاملًا يجمع بين “ذكر السلف من العلماء والحكام”، ويبدو أنه كان يتميز بالأسلوب المصري المعروف فكان “متسلسلا ومشوّقًا ومبهجًا في مجمله”؛ بحسب ابن شاهين الملاطي في كتابه “الروض الباسم في حواديث العصر والتراجم”. ورغم ذلك، كان يتمتع بشخصية محترمة ومُحترمة بشكل كبير في المجتمع، حيث كان “مُحترمًا ومحترمًا في الدُّول”.
أما في كتاباته التي وصفها السخاوي بأنها “زادت على مئتي مجلّدًا كبار”، فقد كان يتسم بالنزاهة في النقل والتوسّع في المعرفة والصراحة في المنهج، إذ “كان ملتزمًا بالأمانة في العرض والاستنباط والجدية في الأسلوب فـ”كان مؤدّبًا وملِّحًا” كما وصفه ابن تغري باردي، وكان يتّسم -في الوقت نفسه- بالموضوعية والتواضع العلمي، وهو ما أتاح له استيعاب الملاحظات والتصحيحات، وكان مستعدًا للعودة إلى الصواب إذا كان هناك دليل جديد وإثباتات، حتى من تلامذته، حيث قال تلميذه ابن تغري باردي عنه: “قرأت عليه العديد من مؤلفاته، وكان يعود إلى كلامي في التصحيح، ويعدل ما كتبه أولاً في مؤلّفاته”.
وتميَّز أسلوبه بالوضوح والسلاسة في العرض، وكان يميل إلى استخدام لغة بسيطة وواضحة؛ لذا وصفه صديقه الحافظ ابن حجر قائلا: “كان يتميز بالتنظيم الفائق، والسرد السلس، والتصنيف البارع”. وكان في نظر تلاميذه “الشيخ الإمام الماهر، عمود المؤرخين، وعين المحدِّثين” بحسب ابن تغري باردي في كتابه “المنهل الصافي”.
كان المقريزي يتمتع بتنوع المعارف واسعًا يتلاءم مع عدد كبير من معلميه الذين اكتسب منهم معارفه المُتنوعة، حيث أشار السخاوي إلى أن “عدد معلميه وصل إلى ستمئة شخص”؛ وكان له تأثير كبير في جذب المعرفة المتنوعة، وقد اتسم بالاهتمام بالمأساة من منظور شرعي وفلسفي، وقد تلقى تعاليم من جميع التيارات الدينية السائدة في عصره، إذ كان تعليمه للغة الأصلية الخاصة به حنبلية، ثم اعتنق المذهب الحنفي تحت إشراف جده وأخذ له، ثم غير إلى المذهب الشافعي، ورغم ذلك كانت لديه بعض الميلات للظاهرية.
وفي سياق الحكم؛ كان الحديث النبوي وعلومه يشغل مكانة مركزية في حياة وأبحاث المقريزي، حيث “شجعت على احترام السنة وأنصح باتباع الحديث والتطبيق”، وهو شيء طبيعي لرجل منتمي للطائفة الحنبلية، وعاش في فترة ازدهر فيها “المدرسة التيمية” وكان ذلك معكوسًا في ترجمة المقريزي الإضافية لابن تيمية حيث قال عنه في كتابه “المواعظ والاعتبار”: “انقسم الناس بسببه إلى فريقين: فريق يتبعه ويعتمد على أقواله وينفذ برأيه، ويرى أنه «شيخ الإسلام» أعظم حافظ لأهل الأمة الإسلامية. وفريق آخر يبتدعه ويضليله ويعتبره بأدلته الخطيرة على خَطَره بإثباته الصفات” لله عز وجل!!
وأعطى المقريزي الاسم ابن تيمية لقدره في عدد من كتبه مثل “إمتاع الأسماع” و”المقفى الكبير” و”السلوك”. وعلى الرغم من أنه كتب مخطوطته “تجريد التوحيد المفيد” بالتأثر بأسلوب ابن تيمية؛ إلا أنه تجنب التحدث عن موضوع “الأسماء والصفات” الذي كان يراه المقريزي سببًا في الحملة الشديدة التي شنَّت ضده من قِبل خصومه، والتي أدت في النهاية إلى حبسه ووفاته في سجن أحدها.
وتركز المقريزي بدلاً من ذلك على تحقيق وحدانية الربوبية وتوجيهها إلى الفوائد الاجتماعية. ولذلك، فإن رسالته نالت قبولًا واسعًا بين الأشخاص البارزين في المنهج السلفي المعاصر، وقام بتدريسها لتلاميذه المعاصرين مثل الشيخ ناصر الدين الألباني (ت. 1420هـ/1999م).
واستبطنا من طبيعة عصره وبيئته أن يكون كان
بما يُظنُّ المقريزي -كعمود أساسٍ لتيار الانصهار العقلي– نزعة عرفانية جعلته يقدّر رموز الحركة الصوفية، إلا أنه لم يتغاض عن انتقاد بعض منهجياتها في زمنه بسبب سلوكيات متهورة، إذ كتب في كتابه “الادعية والتفكير” عن أفراد من هذه المجموعات وصفهم بأنهم “شخصيات تخلص من الالتزامات الاجتماعية والطقوس، ونقص من أعمالهم الدينية باستثناء الفريضة، ولم يهتموا بالتمتع بما هو حلال، واكتفوا بالاستمتاع البسيط ولم يسعوا لفهم الحقایق الجوهرية”!!

انتماء مصري
يلبس المقريزي تقديره لمصر القاهرة بكل ما تحمله تلك الكلمة من اكتشاف كبير لـ”تاريخ العاصمة المحمية” في الماضي والحاضر؛ إذ سجّل لها سلاطنة، وشخصيات مرموقة، ومؤسسات عامة، وآثار عمرانية، ولذا كتب “المؤلفات المميزة بشكل خاص في تاريخ القاهرة”؛ وفقا لشهادة قيمة من صديقه الحافظ ابن حجر في “المجمع المؤسس”.
والحقيقة أن غالبية كتب المقريزي الواسعة في التاريخ كانت متعلقة بمصر كإنسان وحاكم وحضارة؛ ففي تاريخ إنسانها وضع ثلاثية قيمته: «الشرح والتفسير عن العائلة من العرب»؛ و«التاريخ العظيم المسجل» الذي ضم تراجم الشخصيات المعاصرة في مصر؛ و«الجواهر المفتوحة لتراجم الشخصيات المفيدة» حيث قدم للشخصيات التي ترتبط بمصر أو تاتي إليها من بئر، واقتبس عنه ابن تغري بردي قوله حول كتابه هذا: “لو اكتمل هذا التاريخ على ما اختاره لزادت الثمانين مجلدا”!!
وعن تاريخ حكمها؛ كتب ثلاثية في فتراتها السياسية الإسلامية الثلاث المتعاقبة حتى عصره، كما جاء لنا في مقدمة كتابه “السلوك”؛ فكتب عن حقبته السني الأول كتابه “سلسلة الجواهر من أخبار مدينة القاهرة”؛ وخصص لفترته الشيعية الفاطمية كتابه “حكم الحنفاء من أخبار الأئمة الخلفاء”؛ ووضع في فترته السَني الثاني كتابه “السلوك في معرفة أسرار السلاطين”، الذي يحدد بأنه في تاريخ “من حكم مصر.. من الملوك الفرس الأيوبيين والسلاطين المماليك التركيين والشركسيين”. يذكر ابن تغري بردي أنه “يحتوي على تسجيل للأحداث حتى يوم وفاته”!!
وفي تاريخ بناءها؛ ترك المقريزي لنا رسالته الرائعة “إغاثة الأمة بفتح الشاكلة” التي كان أول أعماله عن مصر، وفوق ذلك خلد تفاصيل بناءها -بما في ذلك بناء بيوت الناس من “القصور والمنازل” كما ذكره في “السلوك”- في كتابه الضخم “التراجم والتفقه في ذكر الخطط والتأثيرات” الذي خصصه لتاريخها السياسي والثقافي والبنائي لمدينتها الفاتنة القاهرة. ووصفه ابن تغري بردي هذا الكتاب بأنه “في قمة الروعة”، كما يؤكد فيه -بتنوع محتواه وجودته- قول ابن حجر -في “المجمع المؤسس”- عن المقريزي أنه كتب “المؤلفات المميزة، خاصة في تاريخ القاهرة: فأحيا معالمها، وأوضح مشاكلها، ونشط إنجازاتها، وترجم شخصياتها”!!
ومن المعروف أن المقريزي كانت مصر متنوعة في نسيجها الاجتماعي بتنوعها الحضاري والديني والطائفي؛ لذا تناولت كتاباته هذا التنوع والاختلاف، إذ كتب عن افراد آمنها وجالوتها، وعرقل عناصرها الطائفية والفقهية والعشائرية، وقدم رؤية مركزية للفكر الديني الإسلامي الذي نشأ على أرضها فيما يتعلق بتكونه وتطوره.
ومع ذلك لم تفلح “الأخلاق المصرية” من نتقس الظروف القاسية التي صبت عليها من جهته، وقد قام بأسس ما كتب في هذا على مفهوم خلدوني يربط بين الظروف المناخية والبيئية لكل منطقة وطبائع سكانها وصفات أجسادهم؛ فالمقريزي يبرر نظرته لطبائع المصريين قائلا في “الادعية والتفكير”: “وفيما يخص طبائع المصريين فهي متشابهة لأن قوى النفس تتبع مزاج الجسد، وجسمهم ضعيف يتغير على الفور قليل الصبر والانجذاب”!!
والحقيقة أن حدة نقده لطبائع المصريين بارزة، إلا أنها تبقى مرتبطة بعشقه لبلادهم وتاريخها بكل فتراته ودواهلها، أليس هو القائل في مقدمة كتابه “الادعية والاعتبار”: “مصر هي مركزي الأصلي، ومحور أناط بي، ومستقر أقاربي وأفتخاري، ومسكن قبيلتي وعائلتي، ووطني الخاص والعام”!!
وهذا التضاد في الموقف من الوطن والمواطن يذكرنا بحالة المفكر الجغرافي المعاصر الدكتور جمال حمدان (ت 1414 هـ / 1993 م)؛ حيث امتزجت الافكار الاثنتان لديه في كتابه “شخصية مصر”، مشيرا إلى الإرتقاء بشأن مصر الوطن، والنقد اللاذع لبعض سلوكيات مواطنيها الاجتماعية والسياسية، وربما الجانب المشترك بين المؤرخين هو الكتابة في ظروف الانعزال التي كانت تُحاكيان

روح خلدونية
في تكوينه المنهجي -وبالذات في مجال البحث التاريخي- كانت اللحظة الفارقة تلك التي ربطته بالمؤرخ الديني ابن خلدون، حينما استقر في القاهرة خلال الفترة الأخيرة من حياته 784-808هـ/1382-1406م، قادما من تونس، بهدف البحث عن مكان آمن يطمئن فيه بعد تجاربه الصعبة في الغرب الإسلامي.
عندما وصل ابن خلدون إلى القاهرة، استقبله طلاب العلم بحرارة لتبادل المعرفة، وكان من بينهم المقريزي الذي أطال الوقت في تعلمه واستفادته، وكان لهذا تأثير كبير على ابن خلدون، حتى وصفته في “المواعظ والاعتبار” بأنه: “العالم الكبير، الأستاذ، قاضي القضاة، ولي الدين، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، حضرمي الأصل، وإشبيلي المولد”. كان المقريزي وصديقه ابن حجر، الذين جعلا من القاهرة مركزا آمنا للتعليم والاستيعاب، وقد تركت “المدرسة الخلدونية التاريخية” – التي جعلتهما ميناءا آمنا لتوجيه وتحليل المعارف التاريخية – بصمتها على أجيال عديدة من المؤرخين المصريين.
من ضمن هذه الأجيال، تألق تقي الدين المقريزي كثيرا كواحدٍ من رواد هذه المدرسة، وأبرز شرحاء رؤى ابن خلدون في مناهجه التاريخية، بخاصة في كتابه “المقدمة” الذي أثّر في المقريزي بشكل كبير كما أشاد ابن حجر به في “رفع الإصر عن قضاة مصر” قائلا: “قرأت بخط المقريزي في وصف تاريخ ابن خلدون، وجدت مقدمته فريدة لا يمكن مقارنتها بشيء، إنه لشرف أن يتلقى جاد مُتعبث المخيلة هذه المقدمة، فهي قمة المعارف والعلوم، وبهجة العقول السليمة والفهم المستنير”!
تأسست في القاهرة المدرسة الخلدونية التاريخية التي ارتقى فيها التفكير العميق والنظرة الشاملة، وتم التركيز على القيم الحضارية ورصد تأثيرات الحضارة وكيف تؤثر في حركة التاريخ البشري، بجانب وضع قواعد نظرية للمقارنات التاريخية بين الأمم والشعوب. ولذلك، وكما وصفها المقريزي سابقا في حديثه عن كتاب شيخه “المقدمة”، كانت المدرسة تقف على جوهر الأمور، توضح حقيقة الأحداث والأخبار، تعبير عن وضع الوجود، وتنبؤ بأصل كل موجود، بأسلوب أروع من الدر النظيف، وأنقى من الماء الذي حملته الرياح”!
هذه المدرسة، في الحقيقة، كانت مركزا رائدا في الفكر التاريخي الإسلامي، ولكن ازدهرت بشكل لافت في عهد المقريزي، حيث أصبحت الكتابة التاريخية تشمل السير الذاتية والتاريخ السياسي والاقتصادي للدول والمدن، وتاريخ الأفكار والمعتقدات والطوائف والأديان. ولذا، فإن هذه الكتابات لا تزال ذات فائدة – حتى في عصرنا الحديث – للباحثين في مجالات التاريخ والجغرافيا والشريعة والاجتماع والفلسفة، وتتسع نطاق منظوراتها لتشمل عدة فنون وتخصصات.
ثبتت هذه المدرسة مع ابن خلدون وتلامذته، خصوصا العلماء العظماء الثلاثة: القَلْقَشَنْدي (ت 821هـ/1418م)، المقريزي (ت 845هـ/1442م)، وابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448م)؛ وفي تلامذتهم مثل: ابن تَغْري بَرْدي (ت 874هـ/1470م)، والسخاوي (ت 902هـ/1494م)، والسيوطي (ت 911هـ/1505م) وابن إياس الحنفي (ت 930هـ/1524م)، الذين استلهموا منهجهم.
التوقيع الفكري الخلدوني يتجلى بوضوح في تراث هؤلاء العلماء جميعًا وخاصة تلامذتهم، ليس فقط في تخصّصهم في كتابة التاريخ بشكل محدد وشامل، ولكن أيضًا في نمط التأليف والهيكلية المنهجية في الاقتراب والتقديم، إذ استلهموا وضع “مقدمات” منهجية لموسوعات العلم الكبيرة – التي كانت تزدهر في مصر في تلك الفترة في مختلف ميادين المعرفة – استلهامًا واضحًا من “مقدمة” شيخهم الذهبية لتاريخه المميز: “العبر وديوان المبتدأ والخبر”.
من الأمثلة على ذلك، قام القَلْقَشَنْدي بإعداد جزء منهجي كامل كـ “مقدمة” لكتابه الإداري والأدبي الضخم “صُبح الأعشَى في صناعة الإنشا”، حيث نقل آراء وروايات من شيخه ابن خلدون فيه. وتبع المقريزي ذلك بتكريس الجزء الأول من موسوعته حول أنساب العرب وآدابها، التي نشرت تحت عنوان “الخبر عن البشر في أنساب العرب ونسب سيد البشر ﷺ” كـ “مقدمة” منهجية. وأشار تلميذه ابن تَغْري بَرْدي إلى ذلك في كتابه “المنهل الصافي” قائلا: “له كتاب “الخَبَر عن البَشَر”، تناول فيه القبائل لمنطوق نَسَب النبي ﷺ في أربعة مجلدات، وعمل “مقدمة” له في مجلد”!
وأيضًا، كتب ابن حجر كتابه “هَدْي الساري” كـ “مقدمة” وبوابة منهجية لموسوعته الهامة “فتح الباري بشرح صحيح البخاري”. ولافت أن ابن حجر كان يشير – في كتبه – بشكل كثير إلى«المقدمة» باسم: “هَدْي الساري” أو “شرح البخاري”!!
استطاع المقريزي تجسيد مدرسة ابن خلدون بكفاءة وخدمتها بشكل ممتاز، بل يمكن القول إنه -في كثير من الأوقات- تجاوز في تطبيق نهج ابن خلدون ما قام به ابن خلدون نفسه في كتبه، وهذا الأمر مألوف في التفاوت بين المُقدِّم للنهج والقائم عليه.
قد نجح المقريزي في تجسيد نهج معلمه في العديد من رسائله وكتبه مثل: «اتّعاظ الحنفاء» و«المواعظ والاعتبار»، و«إغاثة الأمة»، و«النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم»، و«الخبر عن البَشَر».
ففي هذه المؤلفات -وفي غيرها من تأليفاته التي زادت وانتشرت في أرفف المكتبات الإسلامية– استطاع المقريزي استخدام المباحث الابن خلدونية في فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية، ربما كتب أول هذه المؤلفات -وهو «إغاثة الأمة»- تحت رعاية معلمه، أو عرض عليه للموافقة عليها قبل نشرها بين الناس، حيث ألّفه قبل وفاة معلمه بشهرين!
استخدم المقريزي في كتابه «اتّعاظ الحنفاء» ما يمكن تسميته بـ “قانون الظهور والتمكين” الابن خلدوني، حيث يتعلق بفهم ظهور الدعوات والدول في التاريخ الإسلامي عن طريق استكشاف حياة أصحاب تلك الدعوات ومراحل نشاطهم، والاعتماد على التحقق الواقعي لأهدافهم كمعيار لفهم الظواهر السياسية وفهم تاريخها.
قد قدّم ابن خلدون نظريته ذلك من خلال فصل شامل في كتبه -في مقدمته- عن الدولة الفاطمية دعوية وقبلية ونسبية، حيث رأى أن كل هذه العوامل ساهمت في ظهور دعوتهم وانتشارها بين الناس استعداداً لإنشاء دولتهم، ولذا كان “انتشار دعوتهم وظهور كلمتهم شيء يدل على صدق نسبهم”.
الاحتيال بالنسب الهاشمية -وفقاً لهذا المبدأ الابن خلدوني- قد يؤدي نجاحاً مؤقتاً أو في نطاق محدود، ولكن لن تقوم دولة على أساس نسبة زائفة بكل هذا التوسع المكاني والانتشار الزماني، خاصة في أمة تعرف بدقة تاريخ عوائلها وتمحص حلقاتها لتحديد الهوية الحقيقية من التزييف الخادع. ومن أجل تأكيد هذا المبدأ؛ قارن ابن خلدون بين نموذجين من التنسيبات الهاشمية الزائفة والصادقة.

توظيف منهجي
نقل المقريزي -في ‘اتّعاظ الحنفاء‘- حُجَج «المقدمة» في تساؤل انتساب الفاطميين إلى البيت الهاشمي، استدراكً ما ذكره ابن خلدون “من ظهور دعوتهم بإفريقية (= تونس وجوارها)، والمغرب، ثم باليمن، ثم بالإسكندرية، ثم بمصر والشام والحجاز”، وكما أنهم حكموا على كل هذه المناطق “بالمساواة مع بني العباس في ممالك الإسلام «شِقَّ الأُبْلمَةِ» (= بالتساوي)، وروءون فيهم مراكبهم، وأثروا بقوتهم. كيف يمكن لشخص يقوم بالمس باستحقاقات النسب أن يُصدّق في تجسيم الأمور؟! وعندما درس حالة القرمطي (= زعيم القرامطة أبو سعيد الجَنّابي المقتول 301هـ/913م) -وهو من جعل مزاعم في نسبه- كيف تلاشت دعوته، واتفقوا تباعه للفساد وخداعهم، فأصابهم عقوبة أفعالهم، ولو تمنت ظروف العُبَيْديين (= الفاطميين) كذلك لكان الأمر ظاهرًا حتمًا… ؛ فدولتهم استمرت لأكثر من مائتي
سنة…؛ لأن الشخص المبتكر لا يظهر حقيقته لا ويختلق بدعته، ولا ينكر هويته المبتدعة، ولا يكذب على نفسه في تنصله”!!
وبناءً على هذا المبدأ الابن خلدوني؛ يقترن المقريزي بمنهج مظفر من الاستناد إلى النصوص والأدلة الاستنتاجية قائلا: “وإذا نجوت من التعصب والرغبة، ونظرت بانتباه إلى المرور الذي تم ذكره من قبل المشككين في أصول الشعوب، تدرك الإفراط
والتهمة مع ظهور التلفيق في الأخبار، وتبين لك من ذلك ما يتعذر على العقول السليمة قبوله، ويشهد الحس المستنير بتدبيره، فقد ثبت أن الله تعالى لا يعين الكاذب المتظاهر بما يؤدي إلى ضلال الناس ليلى وجار أمرهم به، ولقد عرف أن الكذب على الله تعالى والاتهام به -في مطالبة بحق خلافة النبي على الأمة وامامتهم لهم شرعًا- بكونه من أعظم الجرائم والمعاصي، فلا يليق بحكمة الله أن يدعو ذلك الشخص ويمدّه في ظهوره بمساعدته، ويمنحه بدعمه حتى يسيطر على أكبر المدن في الإسلام، ويورثها لأبنائه بعده”.
من الأهمية بمكان في هذا السياق التنويه بأن قبول ابن خلدون والمقريزي بصحة النسب الهاشمي للفاطميين لا يعني إغفالهم للتجاوزات التي قاموا بها فكريًا وسلوكيًا، بل ذهبا إلى ضرورة تفريقهما بين قضية النسب والتحليل الفكري والسلوكي، وعدم جعل أحدهما في موقف كمصدر صواب أو غلط للآخر “فليست.
الابتداع لدى الفريق (= أهل البيت)، أو تجاوز المبالغ من الفريق في شيء من طقوس العبادة، أو ارتكابه ممنوعًا من الممنوعات؛ عندما نتحدث عن نسبهم إلى النبي ﷺ، فالطفل وُلِد على كل تصرف يُجادل أو يُقدم”؛ كما قال المؤرخ المقريزي في كتابه ‘السلوك’.
إذا اعتبر كلاً من ابن خلدون والمقريزي أن الأمورية الفاطمية صحيحة، فقد دعما موقف التيار الواسع من العلماء في “الموقف الشرعي” حول هؤلاء؛ فابن خلدون -في ‘المقدمة’- كان رافضًا “لما كانوا عليه من الانحراف في الدين والتفصيل في المذاهب الشيعية” أي التشيع. والمقريزي أشار إليهم في ‘المواعظ والاعتبار’: “علم أن الناس كانوا شيعة ثم انحرفوا حتى أُنزِلُوا من محبي أهل التشيعً”
وبالتالي، تم تلاحظ على منتقدي المقريزي أنهم اعتبروا كتاباته حول تاريخ الفاطميين تحيزا لهم، واعتبروا ذلك سببًا للانتقادات عليه وأنّ هدفه الرئيسي كان تسويق “مزايا الأسرة الفاطمية”، وهو ما وضحه الإمام الشوكاني في تقييمه لكتاب ‘المواعظ والاعتبار’ للمقريزي؛ فبعد أن أثنى على هذا الكتاب وصفه بأنه “من أفضل الكتب وأكثرها فائدة وفيه رؤى وعبر”، لم يزده غير أن المؤلف “كان ينشر مزايا الأسرة الفاطمية ويصوّر مكانتهم ويحمل على فضائلهم”!! على الرغم من أن الإمام ابن حجر أشهد -في ‘الدرر الكامنة’- على صديقه المقريزي بأنه كان “محبًا لأتباع السنة وميلاً نحو الحديث وتطبيقه”، وهذا ينفي أي نية مُعادية في كتاباته الفاطمية.

تحليل وتوقع
بالنسبة لرسالة «إغاثة الأمة بكشف الغمة»؛ فهي أول كتب المقريزي التي وصلتنا، وحدد لنا تاريخ كتابتها عندما قال في نهايتها: “سهِّلتُ لنفسي ترتيب هذه النصوص وتنقيتها في ليلة واحدة من ليالي المحرم سنة ثمان ومائة (= 808هـ/1405م)”. ووضعها في وقت صعب شهد فيه المجتمع المصري أمراضاً فتاكة ومجاعات شديدة أدت إلى تضخم في أسعار المواد الغذائية ونقص كبير في السكان.
وتظهر الرسالة بشكل عام نهجًا ابن خلدونيًا حيث مزج المقريزي بين الحقيقة والتحليل والتبرير، ومن خلال قراءة فصول مقدمة ابن خلدون وبالذات فصول “الثاني والأربعين المتعلقة بقلة العطاء من الحاكم تؤدي إلى قلة الإيرادات” و”الثالث والأربعين عن الظلم يؤدي إلى تدهور البنية التحتية”، و”الفصل الحادي والخمسين عن سرعة تدهور البنية التحتية نهاية الدولة وتفاقمها بسبب زيادة الوفيات (= تفشي الوفيات) والمجاعات”، سيجد أن طابعها ومنهجها شائعان في رسالة “إغاثة الأمة”، ومخفيان وراء كل استنتاج توصل إليه المقريزي فيها.
ويهدف هذا المهمة إلى تأسيس مبادئ لتحليل الكوارث وإدارة الأزمات الاجتماعية، حتى لا يترك الناس للتوقف والانتظار السلبي أمام موجات الجوع والارتفاع وضربات الكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية، أو ما يمكن أن يطلق عليه ابن خلدون “الأوبئة السماوية”، دون فهم لأسبابها ووعي بالعوامل السياسية والاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقمها وتفاقم نتائجها، ثم يتبع ذلك تقديم السياسات والإجراءات التي تتعامل معها وتقلل من مخاطرها وصولًا إلى علاجها، وهذا ما تحققت فيه هذه الرسالة.
كتب المقريزي رسالته “إغاثة الأمة بكشف الغمة” على أعتاب نهاية عصر سيطرة دولة المماليك، وهي الفترة التي أدركها ابن خلدون نظريًا بأنها “نهاية الدولة [التي] تتخذ فيها الحكومة بلا مساواة وسوء الحكم”، وهي أيضًا -على النحو الذي وصفها- حقبة “تنحصر البنية التحتية” وزيادة “المجاعات والوفيات”.
كان المقريزي مدركًا بدقة لهذا الوقت الحرج الذي وصفه بـ”الغمة”، وعدم إستدراكه أنه يعيش في فترة تراجع لفترة جذابة للدولة المماليك العريقة، وهو الزمن الذي أشار إليه -في كتابه ‘المواعظ والاعتبار’- بأن القاهرة “كادت تتقتّس على ناسها حتى زوح بها وباء سنة تسع وأربعين (= 749هـ/1348م)، وسنة واحدة وستين (= 761هـ/1360م)، ثم زيادة سنة سبع وسبعين (= 776هـ/1374م)؛ حدث فيها إنهيار في عدة أماكن، فإذ بالأحداث والكوارث تنتشر من سنة ست وثمانمئة (= 806هـ/1403م) أدت إلى تراجع القاهرة ومصر وسائر الإقليم”. كان أخر ما كتب عنه في كتابه هذا الفصل السابع الذي “يحتوي على وصف الأسباب التي أدت إلى تراجع إقليم مصر”.
هذه الرؤية المتشائمة لدى المقريزي حيال مستقبل بلاده ليست سوى انعكاس صغير لنظيرتها الأكبر، التي تسيطر على عقلية شيخه ابن خلدون حتى جعلتها دافعًا رئيسيًا لكتابة تحفته: “المقدمة”، وعبّر عنها -في مقدمتها- قائلًا: “وكأنني في الشرق قد تعرضت لنفس ما تعرضت له في الغرب (= من هلاك الناس وتدمير البنية التحتية) ولكن على نحوها وحجمها، وكأن صوت الكون ينادي في الكون بالفشل.
وبدأ الإجابة، إذا وارث الأرض هو الله، ومَن عليها. وعندما تتغير الأحوال، تبدو الجملة كما لو تغير الخَلق من جذورهم وتحول الكون برمته، كما لو كان هناك خَلق جديد ونشأة جديدة وعالَم متجدّد”!
ففي كتاب ‘المواعظ والاعتبار‘ للمقريزي، نقل توقعات بعض الخبراء في علم الفلك -فن الذي كان يتقنه- حيث توقعوا نهاية “عُمْر القاهرة في سنة 819هـ/1416م”، وأشاروا إلى “شواهد الحال اليوم (= تقريبا سنة 817هـ/1414م) تؤكد ذلك من خلال الفقر والفاقة وقلة المال والضياع وتدمير القرى، وتوتر العلاقات الاجتماعية وانحدار الحضارة، وتقترب نهاية حكمهم، وارتفاع الأسعار”!!
واستخدم المقريزي في تلك التوقعات بعض من مقولات ابن خلدون حول علامات انهيار الدول بسبب انتشار الترف و”خراب العمران”؛ فذكر -في ‘السلوك‘- كيف “ازدادت زراعة شجر النارنج…، ولم نشهد مثل هذا من قبل! وقال لي الأستاذ قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون: كلما ازدادت زراعة النارنج في المدينة، كلما اقترب الدمار”!!
واعتبر ابن خلدون انتشار شجر النارنج مؤشراً على انحدار الحضارة وتدهور الأوضاع، بسبب أن النارنج وأمثالها من الأشجار “غير ذات فائدة أو طعم وهي من رموز الرفاهية، إذ لا يزرع في الحدائق سوى لجمال شكلها فقط بعد التفنن في الرفاهية؛ وهذا ما يُهدد بخراب مصر واندثارها”!!
وتوقع المقريزي انهيار “أهل الدولة” في مصر بناءً على توقعات ابن خلدون حين توقع سيطرة العثمانيين على مصر؛ حيث ذكر تلميذه ابن حجر في كتابه ‘رفع الإصر عن قضاة مصر‘: “سمعتُ ابنَ خلدون يقول: ما يُهدد ملك مصر إلا من عهد ابن عثمان”! وبـ”ابن عثمان” يقصد السلطان العثماني في ذلك الوقت بايزيد الأول (ت 805هـ/1402م)!!
وهذا ما تم تحقيقه بعد مرور قرن كامل على صدور تلك التنبؤات، حيث انتصر السلطان العثماني سليم الأول (ت 926هـ/1520م) على المماليك في موقعة الريدانية شمال القاهرة سنة 922هـ/1517م، وتمكن من السيطرة على مصر لأربعة قرون تالية.
ولكن، فشلت توقعات المقريزي في تحديد الوقت الدقيق لهذه التغييرات، ولكنها مازالت واقعية وتبرز الحس القوي للتاريخ؛ فكانت الأوضاع في القاهرة تشير إلى “الامكانية للانهيار” في زمن المقريزي، ولكن مصائر الدول والمجتمعات لا تتبع مصائر الأفراد، فالدول تخضع لقوانين التطور التدريجي نحو الانهيار والتدهور بناءً على مدى “انحراف العمران في المصر”؛ وفقاً لتصريحات ابن خلدون في ‘المقدمة‘.
وكان المؤرخون البصريون يرون تطور الأوضاع في القاهرة بناءً على ما يحدث في نهايات الدول عادة؛ حيث يقولون إن الضعف والتدهور داخل أي بلد “يؤدي إلى تدهور الدولة بحيث تتلاشى ببطىء مثل الحرارة الجسدية في الجسم الذي يتلاشى نتيجة نقص الغذاء، حتى تصل إلى نهايتها المحتومة، فكل دولة لها مدتها المحددة”؛ وفقا لابن خلدون.

رؤية اقتصادية
وتكشف رسالة «إغاثة الأمة بكشف الغمة» عن نظرة متقدمة وفهم عميق يمتلكها المقريزي في مجال القضايا الاقتصادية في عصره، وفهمه العميق للسياسات المالية التاريخية والتطورات التي مرت بها العالم الإسلامي، حيث تظهر الإجراءات والسياسات المقترحة في الكتاب لمجابهة الأزمات -والتي أثبتت نجاعتها خلال عهدي الدولتين الفاطمية والمملوكية- جدوى استخدامها في ظروف الحاضر.
وقد لاحظ أحد كبار المفكرين الأوروبيين، منذ قرنين من الزمن، قيمة المقريزي في التحليل الاقتصادي، حيث ذكر المؤرخ البريطاني روبرت إروين -في كتابه ‘من أجل متعة المعرفة: المستشرقون وأعـداؤهـم‘- أن الفيلسوف الفرنسي سِلفستر دي ساسي كان منبهرًا بآراء المقريزي الاقتصادية، حتى أنه اعتبره “أفضل من معظم المعتقدين الاقتصاديين في أوروبا في ذلك الوقت”، مشيرًا إلى أن “لدى المقريزي رؤى صائبة حول المبادئ النقدية، أكثر صلاحية من العديد من المفكرين في عصرنا”!!
بل، وفقًا لإروين، كان دي ساسي يثق تمامًا في رؤى المقريزي في مجال الاقتصاد، حتى اعتمد على كتاباته حول ملكية الأراضي في الدولة المملوكية، حيث قام بإعداد “رسالة طويلة” تناولت هذا الموضوع.
لتفنيح وجهات النظر في هذه المجال للفيلسوف الفرنسي مونتسكي (المتوفي 1168هـ/1755م)؛ لكي يتحول بذلك تراث المقريزي إلى مادة جدلية في مناظرات الفكرية الأوروبية حول الملكية الاقتصادية في فرنسا في زمن الثورة!!
ومن بين المثبتين لاندماجية مقتضيات المقريزي -حالياً- الخبيران الاقتصاديان ناشر أكبر وعبد الواحد الفايزين في بحث عنوانه: “إثبات فكرة المقريزي لمعيارات التضخم: تحليل تجاوزي للحدود”. وقد نُشر هذا الدراسة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ضمن العدد الخامس من مجلة «الاقتصاد النقدي والتمويل الإسلامي» (JIMF)، التي تصدر بإشراف “بنك إندونيسيا”.
ويلتفت كتاب «إغاثة الأمة» جزء هام في سجل دراسات الاقتصاد العالمي، تلك الذين قدموا تقدمًا كبيرًا في مواضيع الاقتصاد والنقد والتضخم وإدارة الكوارث. أما العبارة المركزية في هذا الكتاب فتتمحور حول أن الجانب البشري يجب أن يتقدم عنصره وتحليله على المستوى الكوني عند تدقيق أثر الكوارث الطبيعية على الدول والمجتمعات.
وقد اتّبع المقريزي هذا النهج في كتابه «المواعظ والاعتبار» أثناء حديثه عن “الشدة المستنصرية” التي ضربت مصر خلال السنوات 457-464هـ/1066-1073م، والذي يعدها “الشدة الكبرى”؛ بسبب ارتفاع “الثمن في مصر في سنة ست وأربعين وأربعمئة (446هـ/1055م)، مما تلته الغلاء ووباء” وباء مِيلَت البلاد وأباد العباد، فهنا يعتبر الخطأ البشري هو العامل الرئيسي في تفاقم الكوارث الاقتصادية، الذي أدى إلى حدوث تلك “الشدة الكبرى” بعد مشوار زمني كامل!!
وعلى صعيد آخر، كان لتلك الأزمة تأثير مكمن في الميدان السياسي؛ بأن كانت السبب البعيد في تراجع مؤسسات الدولة جراء ضعف مركزية “الخلفاء” الفاطميين، وما تلا ذلك من انكشاف لحقبة تولي “الوزراء القوياء” بإسناد المسؤولية الوزارية إلى قائد الجيش بدر الجمالي (المتوفي 487هـ/1096م)، وهذه الحقبة التي استمرت حتى نهاية الدولة الفاطمية -بعد ذلك بمائة عام- على يد الزنكيين بمساعدة الأيوبيين سنة 567هـ/1174م.
ويعتبر كتاب «إغاثة الأمة» أن التضخم والجفاف الكبيرين -اللذين عانت منهما مصر خلال القرنين الهجريين الثامن والتاسع/الـ14-15م- ناجمان عن وفرة الأموال النحاسية العاثرة التي كانت تُبار بدون حسيب أو رقيب لقيمتها (النسبة العملاتية)، وكانت هذه الحالة موازية مع قلة المعروض السلعي بسبب قحط الموسم والعوامل الطبيعية.
ويعتبر الدراسة أن كل ذلك أدى إلى ارتفاع مرعب في الأسعار، وحدوث مجاعات وكوارث إنسانية هائلة في مصر؛ وبالتالي فإن السبب الأول في تفاقم الأزمات الاقتصادية و”إخلال الأمور ليس سعر المنتجات بل سوء التصرفات”، وهياكل الضرر هي “فساد المسؤول في تولي النظر في ذلك وجهله بسياسة الأمور، وهو الأكثر شيوعًا في الغالب”.
وتثبت هذه المعادلة المقريزية بنتائج الدراسات الاقتصادية الحديثة التي قدمت أن “تكشف الأدلة التجريبية [اليوم] أن معدل التضخم يتداخل بشكل ايجابي مع عوامل السوء البشري”، وأن “السوء البشري هو الجزء الأساسي المُقدم للتضخم، وتتضمن هذه المعايير: مستويات عالية من الفساد، وأسعار الفائدة والضرائب، وتضخم كمية النقود المُتداولة”؛ وفقًا للدراسة الإندونيسية المشار إليها سابقًا.
تلي ذلك تأثيرات “الوباء” المُضاغفة جراء الإهمال في معالجته في الوقت المناسب، وبذلك “يعمّ السوء التدبير وفساد الرأي” وظلم الكارثة الطبيعية “ينتىء في البلاد والعباد” فيُضاعف المشكلات؛ ومن ثم “من رأى هذا الحادث (= أزمة مصر في زمانها) من بدءه وحتى نهايته، وفهمه من أوله وإلى آخره؛ فقد علم أن فعل الناس واقعًا من سوء تدبير الرؤساء والحكام واهمالهم في النظر لمصلحة العباد.”.
يحكم المقريزي أن الإدارة الصحيحة قادرة على وضع حلول تضع الأمور في أدنى المستويات إذا لم تكن قادرة على حلها بشكل شامل؛ لأن “الأمور جميعها وأغلبها إذا عُرفت أسبابها أصبح سهل على الماهر حلاها”، وأن تدبير الأزمات ومواجهتها أمر ذو تنظيم الكفاءة للمحترفين بها من البشر لأن الله تعالى قد “منح قومًا فجعل لهم على ما خفي من إبداع صنعته…، وأعطاهم توضيحًا وحكمًا، وأوحى لهم معرفة ومعرفة، ودعمهم في أقوالهم وساندهم في اعمالهم، حتى تفصح للعباد أسباب التجارب التي نزلت من الحوادث، وتعرفهم كيفية النجاة من الشديد المحن.”.
يأتي الفصل الأول من الكتاب بعنوان: «فصل في ذكر ما حدث في مصر من الغلوات (= تضخم/غلاء) وحكايات سهلة من أخبار تلك الأزمات». وفي هذا الفصل يوضّح المقريزي أن “التضخم والازدهار ما زالا يعقبان في «ثنائية الدنيا والخراب»”، أي في مجتمعات البشر.
من خلال نقل تلك الأخبار يُمكن أن ينتج تأثير نفسي على القارئ يلغي لديه الوعي الكاذب بمدى الصعوبات التي تواجهها المجتمعات، ويدفعه نحو التحرر من الانحباس في الكفاح المعيشي، ويشجعه على دراسة سير التقلبات والازدهار التي شهدتها الدول عبر التاريخ، والسعي الجاد للتصدي للمشاكل من خلال تحديد جذورها البشرية وتحليل أسباب تكرارها ومعالجتها، على غرار القادمين بحكومة فاعلة تستطيع إدارة الأزمات بكفاءة عالية، والتعامل بحكمة مع سلوكيات الازدهار والصعوبات التي تتناوب على المجتمعات دون أن تسلم أي منها أمة.
وقد استنتج المقريزي ثلاثة عوامل رئيسية رآها أسبابًا للأزمات الاجتماعية والتي تسبق أو ترافقها، وأبرز تلك الأسباب هو الفساد الذي جعل السلطة السياسية والتنفيذية والقضائية في البلاد مرتعًا لكل من يتسم بالجهل والفساد والظلم والفوضى يسعى لتولي المناصب الحكومية والمسؤوليات الدينية بالرشوة، مثل الوزارة والقضاء وإمارة الأقاليم وولاية الحسبة، وجل هؤلاء الحكام الفاسدين ليس لديهم ثروة مما دفعهم للاستدانة من أجل دفع تلك الرشى للحاكم، وبعد توليهم الوظائف تصبح كل وظيفة نقطة اجتماع للفاسدين الأصغر سواهم، وهكذا ينتشر الفساد في أعضاء الدولة من الأعلى إلى الأسفل.
عندما يكون رأس السلطة فاسدًا، يجد في مصلحته أن يتجاهل ما يأخذه من الأموال بمختلف أشكالها، ولا يكترث بما يتلفه من شخصيات، ولا بالدماء التي يراقها، ولا بالاضطهاد الذي تتعرض له النساء، ومن الطبيعي أن تكون التكلفة باهظة على الجماهير مثل الفلاحين “وعندما أصيب أهل الريف بكثرة الديون وتواتر الظلم، تغيرت ظروفهم وانهارت وحدهم، وغادروا أوطانهم، وتقلصت مداخيل البلاد ومواردها بسبب قلة الإنتاج فيها، ولأن سكانها كانوا يعانون من تباطؤ النمو في ظل قمع الحكام الذين فرضوا عليهم، فأصبحوا مجبرين على ترك الحقول أكثر من الزراعة، مما أدى إلى ندرة المحاصيل وغيرها من موارد الأرض”.

تأثير تحفيزي
إذا كان النظام السياسي مبني على الفساد عندما يتضاءل أو يمر بفجوة، فإن الفوضى السياسية والأمنية ستنغص بما يدينه، وهذا ما حدث في أيام المقريزي؛ حيث وقع “اختلاف بين الجهات الحاكمة آل إلى تنازع وحروب.. وتمرد أهل الريف وانتشار المجانين (= اللصوص) وسطوة الطرق، فزلزلت السُبل وعسر الوصول” إلى المناطق الآمنة.
و”ظاهرة الفساد” التي اقترحها المقريزي كسبب رئيسي في تصاعد معدل التضخم، تم تأييدها من قبل بعض الدراسات الاقتصادية الحديثة؛ حيث قام أحد الباحثين بدراسة على 41 دولة في فترة الزمن بين 1980 و1995، وأظهرت النتائج أن الفساد يؤثر سلباً على التضخم. وقد أجريت المزيد من الدراسات الحديثة على 25 دولة نامية أظهرت أن معدل التضخم يرتفع كلما زاد مستوى الفساد.
أما السبب الثاني الذي ينظر إليه المقريزي كجذر للأزمات الاقتصادية هو انضمامه إلى نظام الاقطاع المملوكي الذي بدأ في العراق خلال عهد الوزير السلاجقة المُلك نظام (ت 485هـ/1092م) كوسيلة لتوظيف قوات الأمن وجنود الجيوش، وتحول في نهاية عصر المماليك بمصر والشام إلى نظام سيء ينخره الفساد ويَغطّيه الظلم، وهو نظام يعتمد على تكليف الأمراء -من قادة الجيوش وأصحاب السيوف- بإدارة مساحات شاسعة من الأراضي، فيستفيدون منهم هم وعسكرهم مقابل جبايات تُسدد لصالح الدولة.
وبناءً على ذلك، كان جشع طبقة أمراء الإقطاعيات ورغبتهم في تراكم الثروات يدفعهم إلى تعنيف أتباعهم -الذين كانوا يصلون برشوة منهم- في التعامل مع الفلاحين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم بسبب زيادة أجور الأراضي دون مقابل مناسب “لذلك زادت الزيادة كل عام، حتى بلغ سعر الفدان في تلك الفترة حوالي عشرة أضعاف ما كان عليه قبل هذه الأحداث”! ونتيجة لذلك كانت “تزايدت تكاليف الزراعة والبذر والحصاد وغيرها، وارتفعت مستويات الفساد والمظالم، وزاد الضغط على أهل الفلاحة، وتعثرت أكثر الأراضي عن الزراعة، مما أدى إلى نقص المحاصيل وسواها من إنتاج الأرض”!!
وكان الإمام تاج الدين السبكي (ت 771هـ/1369م) قد سبق المقريزي في انتقاد النظام الإقطاعي المملوكي؛ إذ قال -في رسالته ‘مُعيد النعم ومُبيد النقم‘- “من أشد الأفعال المنفرة في إدارة الجيش إلزام الفلاحين في الإقطاعات بالزراعة، ويجب أن يكون الفلاح حراً دون إلزام، حيث أنه سيد لنفسه”.
تحدث كذلك عن أسلوب ساخر وصل إلى حد العبودية قائلاً: “وكان العرف في بلاد الشام أن من هاجر دون تجاوز الثلاث سنوات يُلزم ويعاد إلى القرية بالقهر، مما يظهر
بفضل الزّراعة، وفي غير سوريا أصعب حالًا منها. واعتبر المقريزي هذا الاستعباد الذي يمارس على الفلاح “نوعًا من الإسترقاق يورّث للفلاح أن يصبح “عبدًا لصاحب المزرعة وورثته
وأدى هذا النظام الزراعي في عهد العثمانيين إلى إصلاحات جذرية في مصر بواسطة واليها العثماني محمد علي باشا، الذي ألغى هذا النظام بالكامل. وأصبحت الأراضي تخضع لإدارة الدولة وتحصيل الضرائب.
وسمحت هذه التحديثات لمحمد علي بإصلاح أنظمة الري واستصلاح الأراضي الزراعية. قدم الفلاحون “حق الاستفادة [من الأرض] دون التوريث، وثمنتُها سعيد (=والي مصر سعيد بن محمد علي إلى جانبه”، حسب جمال حمدان في كتابه ‘شخصية مصر‘.
أما السبب الثالث للأزمات الاقتصادية حسب المقريزي؛ فهو تراجع استخدام النقد الذهبي والفضي، وانتشار النقود النحاسية التي أصبحت الوسيلة المتداولة بدلاً من الدينار والدرهم، فشهد انتقالاً كبيراً في وسائل الدفع في تلك الحقبة.
قد مرت فترة عصر المقريزي بتزايد استخدام النقود النحاسية بعد أن بدأت السلاطين في ضربها بكثرة، ودخل النقد الزائف في تلك السوق، ولم تكن تحت إشراف واضح كالذهب والفضة أو بسعر صرف ثابت، مما أدى إلى تضخم النقود وانتشارها، وصارت “لا تكفي لشراء البضائع الراقية، إنما لصرف الانفاق اليومي”.
وعرض المقريزي حلاً بإعادة استخدام النقود من الذهب والفضة كوسيلة دفع معتمدة طبقاً للشريعة والتاريخ، واقترح حلاً مؤقتاً لمحاربة التضخم بتحديد قيمة النقود النحاسية بالدينار أو الدرهم، لتحسين الأحوال الاقتصادية.
وما زالت فكرة المقريزي في محاربة التضخم من خلال الاعتماد على النظام النقدي الذهبي موجودة في الدراسات الاقتصادية المعاصرة. فقد اوصت دراسة إندونيسية بالعودة إلى استخدام الذهب والفضة كنقود عالمية، تماماً كما اقترح المقريزي!!

توثيق عمراني
ظل التاريخ الإسلامي يعتمد على المنهج الذي وضعه الطبري، بالتاريخ المتسلسل لأمة واحدة، ولكن بعد ضعف الخلافة وظهور مراكز سياسية وحضارية جديدة؛ بدأت يظهر التاريخ المحلي والإقليمي الذي يكتبه أبناء الإقاليم عن مدنهم وثقافاتهم.
ولم تكن تلك الكتابة تمثل اتجاهًا وطنيًا أو قوميًا، لأنها كانت مرتبطة بحضارتها، ولم تكن تعبر عن عزم على الفصل أو الفصل عن الأمة الواحدة.
كتابات التاريخ الإقليمي والبلداني في عهد المقريزي جسّدت الانتقال من التاريخ العام للأمة إلى التاريخ المحلي، من اهمها “تاريخ واسط” للواسطي، و”تاريخ داريا” للخوْلاني، و”تاريخ.
المراجع العربية القديمة تشمل كتب مُتنوعة مثل “الجُرْجان” للكاتب حمزة بن يوسف السَّهْمي (ت 427هـ/1037م)، و”ذكر أخبار أصبهان” للمؤرخ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430هـ/1040م)، و”تاريخ صنعاء” للمؤرخ إسحق بن يحيى بن جرير الطبري الصنعاني (ت نحو 450هـ/1059م)، و”تاريخ بغداد” للإمام الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م)، و”تاريخ مدينة دمشق” للحافظ بن عساكر الدمشقي (ت 571هـ/1175م)، و”بغية الطلب في تاريخ حلب” لكمال الدين ابن العديم (ت 660هـ/1262م)، و”الإحاطة في تاريخ غرناطة” للمؤرخ والأديب الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب (ت 776هـ/1374م).
ربما كان هذا الأسلوب من الكتابات هو ما حفز المؤرخ المقريزي ليقول إن لكل أمة من الشعوب -رغم تباين آرائهم واختلاف عقائدهم- قصصاً معروفة ومشهورة بينهم، ولكل بلد من الدول المأهولة حوادث مرت بها يعرفها العلماء في كل عصر. ولو تحققت كل ما كتبه علماء العرب والأجانب في هذا المجال لزادت الكمية، وتعذرت الإمكانية البشرية على تحقيق ذلك.
واستنادًا إلى هذا المعطى، وبتطوير المخرجات التاريخية والجغرافية لها، ظهرت كتب “الخطط” أو مدونات الطبوغرافيا الثقافية والسياسية والاقتصادية التي ألفها المؤرخون المسلمون. هذا الفن الموسوعي كان من بين ملامح الحضارة الإسلامية ويمكن وصفه بأنه تمثيل ثانوي لقوالب الكتابة التاريخية، ولكن هذه المرة من تواريخ البلدان إلى تواريخ المدن الإسلامية: مناطق وهياكل ومؤسسات.
تلك الكتابات تعتمد على الجغرافيا الحضرية بمختلف أبعادها العمرانية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وأكثر المدارس شهرة هي تلك التي نشأت في مصر ونمت بها مع المقريزي في كتابه الضخم “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار”، حيث قدم فيها تقديمًا شاملا وموثوق لما توصل إليه العلماء المصريون في هذا النوع من الكتابة التاريخية الحضرية، بعد أن “ازدادت مدى الإنتاج الكتابي في كتب “الخطط” وانتشرت في عهد الأيوبيين والمماليك”، وفقًا للمستشرق الألماني فرانز تيشنر (ت 1387هـ/1967م) في فصل “الجغرافيا” الذي نشره في كتاب “موجز دائرة المعارف الإسلامية”.
فيما يتعلق بكتاب “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار” المشهور بـ “الخطط المقريزية”؛ كان محل اعتزاز وثناء العلماء والمؤرخين في عصره لأنه الكتاب الذي أحيا تراث القاهرة بعد أن اختفى الكثير منه وكان المتبقي مهدًا للضياع.
والحقيقة أن المقريزي -الذي ركز في كتابه هذا على القاهرة معظم الوقت الذي قضاه في تأليفه وتنقيحه لمدة 28 عامًا- لم ينسَ ذكر غيرها من مدن مصر وأحوالها. ولذا، ليس من المستبعد أن الوزن غير الجانبي لعلماء الإجتماع موسوعة المقريزي القاهرية يتعدى الفترة الزمنية التي عاصرها، حيث قال علي مبارك في “الخطط التوفيقية الجديدة”، التي تعتبر تكملة لخطط المقريزي التي استمد الكثير من فكرتها منه: إن “العلامة المقريزي لم يتوقف في “خططه” عن مدينة القاهرة، بل تحدث عن العديد من مدن مصر”.
وخلافًا لما اعتقد بعض الناس، فإن تقدير موسوعة المقريزي القاهرية يتعدى الخصوصية المُكلفة التي اجتذبت المؤرخين الغربيين، حتى المستشرق الفرنسي أندريه ريمون (ت 1432هـ/2011م) كان ناجحًا في ربطها بين “الخطط المقريزية” وموسوعة “وصف مصر” الضخمة، التي عمل عليها -بالنصوص والرسوم- مئات المستشرقين الفرنسيين على مدى 25 عامًا، حيث زاروا مصر وعاشوا بها كأتباع لجيش الحملة الفرنسية بقيادة الإمبراطور نابليون بونابرت (ت 1235هـ/1821م) خلال فترة الاحتلال الفرنسي لمصر وسوريا، والتي استمرت -قبل هزيمتهم- منذ 1212هـ-1215هـ/1798م-1801م.
فيما يتعلق بكتاب “سكان القاهرة من المقريزي إلى وصف مصر” (La population du Caire de Maqrīzī à la Description de l’Égypte) الذي كتبه المستشرق الفرنسي أندريه ريمون (ت 1432هـ/2011م)، استطاع أن يربط بين “الخطط المقريزية” وموسوعة “وصف مصر” التي جمعتها الكتاب -نصوصًا ورسومًا- المئات من العلماء الفرنسيين خلال حقبة 25 عامًا، حيث زاروا مصر وعاشوا بها خلال فترة الاحتلال الفرنسي لمصر وسوريا، والتي استمرت -قبل هزيمتهم- بين 1212هـ-1215هـ/1798م-1801م.
لا يمكن تجاهل تأثير الكتب العربية القديمة كـ “الخطط المقريزية” في الحفاظ على تراث القاهرة وخارجها، حتى إن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجَبَرْتي (ت 1240هـ/1824م) -الذي شهده إحتلال نابليون وتفاعل مع علمائه- لا يمكن أن يتجاهل الإشادة بكتب المقريزي مثل “الخطط”، حيث وردت الإشادة بكتاباته في كتاب “عجائب الآثار في التراجم والأخبار”. من المحتمل أن كتب المقريزي كانت من بين المخطوطات العربية التي بدأ الأوروبيون ينقلونها بشغف إلى بلدانهم منذ القرن السابع عشر، وذلك خصوصًا مع التأكيد على تلقي أحد الباحثين ا
لاوروبيين على يد الشيخ حسن الجبرتي، الذي كان منقذًا من الجامع الأزهر قبل الغزو الفرنسي لمصر بخمسين عامًا.
حينئذ، بتلك المعرفة، وأسحبوها من القوة إلى الفعل”!!

معانٍ هامة
في الواقع، أحاط المقريزي بتفاصيل نحو نصف ألف سنة من تاريخ القاهرة العريقة، التي تعود أصول تأسيسها إلى عواصم مصر الإسلامية الأولى، قبل أن تصبح “القاهرة المجيدة رابع موقع تنتقل فيه الحكومة من أرض مصر في الدولة الإسلامية”؛ كما ورد أنها “خُلقت [لتكون] مسكنًا للخليفة وجنده والأشراف، ومكانًا للحروب التي يحصن فيها ويحتمي بها، وظلت هكذا حتى أصبحت «العاصمة العظمى» في خلافة المستنصر” الفاطمي.
ويرصد المقريزي -في هذا الكتاب- تلخيصًا موجزًا عن العواصم المتعاقبة لمصر منذ العصر الفرعوني؛ حيث يشير إلى أن بعد فتح البلاد على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص (رضي الله عنه) (664م) “احتكم إلى مدينة «فسطاط مصر» كموقع للحكم من ذلك الوقت إلى اختفاء دولة بني أمية ودخول جيوش بني العباس إلى مصر، وتأسيسهم -في فسطاط- «العسكر» حيث كان الأمراء أحيانًا يتواجدون في العسكر وأحيانًا في فسطاط، حتى بنى أحمد بن طولون (884م)… «القطائع» جنبًا إلى جنب مع العسكر لتصبح القطائع مواقع للعائلة الطولونية حتى اضطرت دولتهم إلى الرحيل، وعاش الأمراء… في العسكر حتى جاء جوهر القائد (992م) من بلاد المغرب بالقوات المعزية لدين الله وأسس “القاهرة المجيدة”، حيث أصبحت القاهرة مركزًا للخلافة ومقرًا للإمامة ومأوى للحكم”!!
تُعد القاهرة من العواصم التي تدفع حاكمها نحو الطموح السياسي؛ إذ تحمل في داخلها موروث الاستقلال وروح القيادة منذما رفعتها الدولة لفاطمية لتكون عاصمة خلافتها الغنية بالأحداث، وحتى عندما سقطت سلطانتهم بيد صلاح الدين الأيوبي (1193م) “انتقل من القاهرة إلى قلعة الجبل حيث استقر هناك مع جنوده والأشراف، واستقر فيها العلماء بعد زمن طويل، فأصبحت القاهرة مدينة مأهولة بعد أن كانت حصنًا للمعتقلين (= للحصار)، وعاصمة يُشرف عليها، فقد فقدت بعد العظم وانخفضت بعد الاحترام”!!
والقاهرة هي “مدينة مصر” -كما وصفها المقريزي- ومن خلال تاريخها “يمكن للشخص في وقت قصير أن يستكشف ما حدث في أرض مصر من أحداث وتغييرات على مر العصور والسنين الطويلة”. وعند دراسة القاهرة، فإنه يجب بالضرورة مراجعة تلك التحولات والمسارات في تدفق الدول المتعاقبة مع كل مظاهرها العمرانية، وأحداثها السياسية، ومؤسساتها الحضارية، لأجل “الإشارة إلى الذي أقامها من حكماء الكبار والمشاهير”، والوقوف على “تقارير وأخبار ما ظلت في أرض مصر من آثار تبقى من الحضارات السابقة والعصور الماضية”، وتوثيق “آثار القصور البارزة وكل ما تضمنه من مخططات وأركان وتحف فنية”.
بدأ المقريزي كتابه بتعبير الفخر بمصريته، مبررًا رغبته وإلهامه لتأليف هذا السفر؛ حيث قال: “مصر هي وطني الأصلي، وساحتي البهية ومركز تجمعي، وسكن عشيرتي وأقاربي، ومملكة خاصتي وعامة، وقلبي الذي نما جناحه ورعاه، وعشت مدى حياتي لا تعشق الأرواح سواه”!! وقد كان المقريزي “وطنيًا حميمًا لوطنه”؛ كما لاحظ جيدًا تاريخي الحضارات الأميركي ويل ديورانت (1981م) في كتابه ‘قصة الحضارة‘.
وفي الفصول الأولى من هذا الكتاب؛ وصف المقريزي نظرة سريعة عن جغرافية مكان مصر في العالم، وموقعها بين الأقاليم السبعة وفقًا لتقسيم الجغرافيين القدامى، ثم شرح حدودها وتوجهاتها وأصل اسمها ومعناه، وناقش خصائص بيئتها وأحوال طقسها، وقدم عناصر تحفها وعلمها، وتناول كنوزها وآثارها وكنوزها، وتطرق إلى زوال ثرائها ومواردها.
وبالنسبة لمدينته العريقة، القاهرة؛ قام بجولة في شوارعها واستكشاف حاراتها، وكتب عن مدارسها ومراكزها، وتابع مجريات نهرها وأفرعها وحركة السفن والقوارب فيه، وتفقد تفاصيل تاريخ مرافقها ومؤسساتها، وعرض احتفالاتها وجوانب فرحها، وكشف عن حزنها ومعاناتها خلال الأحداث الصعبة، ونقل عن مكوناتها الثقافية ودوّن معتقدات دياناتها وطوائفها، وسجل تيارات الأفكار والاتجاهات والمذاهب: كيف ثبتت؟ وكيف انحسرت؟ وما يظل منها؟ وما الذي اختفى؟!
لقد تناول المقريزي في كتابه الإنسان في مصر بجميع أوجهه: سواءاً كان سنياً أو شيعياً، قبطياً أو يهودياً، فلاحاً أو صانعًا، سلطاناً أو عالمًا، موظفًا أو تاجرًا، وظهر واضحًا احترامه للوطن، وجرأته في تقديم النقد للوضع السياسي، وحبه العميق لمصر بكل تشاؤمه。
بمجرى مصيرها!
فيما بين المزايا والعيوب؛ جرى حديثه عن محاسن مصر ومناقبها وأخلاق أهلها وطبائعهم وتكوينهم. هنا يعثر القارئ على نفسه مقابل فصلين يظهران كالمتناقضين: أولهما حول محاسن الوطن، وثانيهما يناول بعض نقاط الضعف للمواطنين.
ومن الواضح أن موضوع “أخلاق الشعوب” لطالما كان جانبا يثير اهتمام علماء الأخلاق بالطريقة التي ظلت فيها محط اهتمام بين المدافعين عن العادات الشعوبية ونقادهم، والرأي النهائي في ذلك هو ما ذكره أبو حيان التوحيدي -في كتاب ‘التأمل والتفكر‘- بأن الأمر غير ثابت، والتعميم فيه -بشكل سلبي أو إيجابي- يشوبه العديد من التحديات “لأن لكل جماعة مزايا وعيوب، ولكل قبيلة مزايا ونقائص، ولكل مجموعة من البشر في أعمالها وسلوكها واتجاهاتها كمال ونقص، وهذا يعني أن الخير والفضائل والشرور والعثرات متواجدة بين جميع الأفراد، متقاربة بين الجميع…؛ بعد ذلك، فالمزايا المذكورة في هذه الأمم… ليست موجودة لكل فرد منها وإنما هي مشتركة بينهم، وهناك في إجمالها من هو عارٍ على جميعها ومحمل بضدها”!!
وقد أثار المقريزي جدلا واسعا بكلامه حول أخلاق المصريين وشهدت ذلك نقاشات طويلة؛ ففي فضائل مصر يروي أنها تلك الأرض التي ذكرها “بالذهب في كتابه المختصر بضع وعشرين مرة تارة بوضوح وتارة بتلميح”، وهي “كنزات الأرض كلها، وسيطرتها سيطرة الأرض كلها”، كما أن “مَن أراد أن يرى شبيه الجنة فلينظر إلى مصر”، وهي أيضا “وسط الدنيا”. وما يلافت النظر هو أن هذه العبارة الأخيرة تستخدمها جمال حمدان -في كتابه ‘شخصية مصر‘- من دون أن يرتبطها بالمقريزي!!
فيما يتعلق بالجزء الذي يتحدث عن أخلاق المصريين؛ يجب أولاً أن نذكر أن النقد الذي قدمه المقريزي لسكان عصره يجب فهمه في إطار ما يمكن تسميته “أخلاق الأزمة”، إذ جاء نتيجة لما “تعرضت له البلاد من محن، وما تعبَّوا به من تفاقم الأزمات”!! وإذا فحصنا لغته سنجد أنه يقدم لنا صورة عن أخلاق “زمن الأزمات والتحديات” هذا، مسلطا الضوء على السلبيات التي تتجلى في الطبيعة الإنسانية -سواء في أي شخص أو في أي موقع- خلال الظروف الاجتماعية الصعبة.
وهكذا، وفقًا لهذا النهج المُحدد؛ يمكن فهم تصريحاته حول المصريين مثل قوله بأن “أخلاقهم مرهونة بالتغيير والانتقال من شيء إلى شيء…، واليأس والبخل، وقلة الصبر…، والهلع والغيرة والنميمة”!! أو تأكيده على أنهم يتحكمون فيهم “باتباع الشهوات والانغماس في لذاتها، والتفرغ للأوهام والاعتقاد بالمستحيلات، وضعف العزائم والإرادات”!!

سياقات مقيدة
والحقيقة أن كل من الموقفين: الإيجابي نحو مصر تاريخيا ودورها، والسلبي تجاه المصريين المعاصرين له والذين عاشهم، ترثه المقريزي عن شيخه ابن خلدون الذي قال -في كتابه ‘رحلة ابن خلدون‘- مدحا عاصمتهم القاهرة بأنها “عاصمة العالم وحديقة الكون، ومركز الأمم ومحور البشر، وعقد الإسلام”!! وفيما يتعلق بالمصريين الذين عرفهم لاسيما في نشاطه القضائي فقد قال عنهم -كما ورد منه في كتاب ‘الحكمة والاعتبار‘- إن “سكان مصر يعيشون وكأنهم قد اجتازوا الحساب الروحي”، إذ “يسود الفرح والمرح والاستهتار بالعواقب”!!
فإن هذا الحكم -الذي يظهر بقسوة- ليس نابعا من ازدراء لمكانة أهل مصر ولا تقليل من قيمتهم، فالمحتوى بأكمله كله كان تاريخيا لجهود القاهرة الحضارية، واحتراماً لجهود الزعماء السياسيين والشخصيات العلمية، وأداء المؤسسات الرسمية والهيئات المجتمعية والبنى التحتية للمجتمع، بالإضافة إلى ما شملته مؤلفات المقريزي التاريخية والسير الذاتية الأخرى من إشادة بأبرز شخصيات المصريين من العلماء والحكام والرجال والنساء.
لكن الظروف القاسية التي واجهها المقريزي وحملت معها هي التي أعمقت في رؤيته للأمور ودفعته نحو تلك التعميمات الظالمة والاتهامات الجاحظة؛ فعلى المستوى الشخصي لا يمكننا تقدير دور المآسي العائلية التي عانى منها حياته الخاصة بفقدان أفراد عائلته تباعًا؛ بدءًا من وفاة زوجته الأولى وأم ولديه الأكبران محمد وعلي: عمرة بنت عمر بن عبد العزيز (ت 790هـ/1388م) التي ظل دموعه عليها تسيل حتى وفاته، ولقد وصفها -في كتابه ‘درر الأعمال الفريدة‘- بأنها “من أفضل النساء في عصرها بأنها طاهرة ومحافظة ومتدينة وأمينة وحكيمة وودودة، ولم يُعوض عن وفاتها شبيه لها”!! وانتهاءً بفقدان ابنته الأخيرة: فاطمة التي وصفها -في كتاب ‘سلوك‘- كجزء من روايته لوفيات سنة 826هـ/1423م: “وتوفيت ابنتي فاطمة يوم الأربعاء”.
في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول؛ كان آخر فرد يعيش من أبنائي، عندما بلغ سبع وعشرين عاما وستة أشهر!!
على الصعيد العام؛ شهد المجتمع المصري في تلك الحقبة “كثرة الصراعات والشقاق بين أفراد الدولة”، وكان يعاني من “سوء أوضاع الشعب، والانتشار الواسع للفقر والحاجة والمعاناة بين الناس، وارتفاع نسبة المظالم التي فرضها حكام الدولة”، مما أدى إلى “تقلص مساحة العدل وانتشار الفساد، وظهور وجوه الإثم بوضوح، وانحدار التكافل الاجتماعي، واندثار الحياء والشرف من نفوس الناس، حتى أصبح بإمكان أي شخص فعل ما يشاء”!!
لا يوجد وصف أكثر دقة أو أكثر ألمًا من اقتباسه -في “إغاثة الأمة”- لظروف الطبقات الاجتماعية الوسطى خلال تلك الفترة الصعبة، وبالأخص فئة العلماء التي ينتمي إليها؛ إذ كانوا “من الفقراء وهم جلّ العلماء وطلبة العلم..، وكانوا بين المحتاجين أو المتوجهين نحو الموت بسبب ما ألمّ بهم”!!
في مثل هذه الظروف “تتبدل الأوضاع وتتحول الظروف” كما أوضح المقريزي بتلك العبارة التي تشير إلى تغير الأوضاع الطبيعية، حيث تبدأ الأنظمة السياسية بالتلاشي، والقيم الأخلاقية بالانحدار، وينتشر التفكك في البنية الاجتماعية. وفي لحظة “الانهيار” كما وصفه ابن خلدون، تظهر عادة في آخر حقب الدول، عندما يزداد تفاقم المعيشة وترتفع تكاليف الحياة ويبذل رجال السلطة المال في الترفيهات، فيزيدون الضرائب على الشعب وبذلك يكون منطبقا “الظلم في الأموال والجبايات”، وتتزايد المجاعات “ليعجز الناس عن مواصلة الزراعة”.
ويرى المقريزي أيضًا -متأثرا بابن خلدون- أنه في فترات زوال الدول تظهر ما يشبه “التحول في الخلق والأخلاق يعلن عن نشوءه في الصفات والأشخاص” البشرية؛ حيث يتمثل هؤلاء “الأشخاص المسخ” من المواطنين في تجليات الأخلاق الفاسدة التي وصفها شيخه، وبذلك يصبحون “مستعدون للكذب والمخادعة والغش والسرقة والفجور في الأقسام والربا في التجارات”، وعندئذ “تصبح المدينة موطنا للأفراد ذوي الأخلاق الفاسدة”، ويكون النتيجة “عندما يفسد الإنسان في أخلاقه ودينه فإنه قد انحرف عن إنسانيته وأصبح مسخا على الحقيقة”!!
إذًا بين تمجيد الوطن وانتقاد المجتمع هناك خط رفيع، يجب التمييز بين الرؤية التي يعبر عنها المقريزي وشيخه ابن خلدون بخصوص مصر بناء على مكانتها الجغرافية والثقافية والتاريخية البارزة في مجال الفضائل، وبين تصريحاتهما التي تحدد مشاكل المجتمع التي تظل موجودة -مهما بدت صعبة- في انتظار ظهور منقذ يعيد البلاد إلى سبيل التفوق الحضاري، كما حدث في فترات تاريخية سابقة قبل عصر المقريزي وبعده.
من الضروري هنا أن يؤدي دور المثقف الواعي تجاه مجتمعه وأمته إلى اشارة إلى العيوب والمشاكل، دون أن يعتبر ذلك افتضاحًا أو تشهيرًا حتى وإن كان لغته قاسية وكلامه صارم. وربما كان جمال حمدان يهدف -حتى وإن لم يذكر- إلى انتقاد المقريزي بشأن الشخصية المصرية في عصره، عندما قال “إن أشد المنتقدين لنقاط الضعف والنقائص في الشخصية المصرية هم عادة الوطنيين المتميزين بالطموح والاخلاص، وأكثرهم حبًا لمصر واهتمامًا بها ورغبة في تقدمها وازدهارها”.
وقد اتبع المقريزي نفس الفكرة في السياق المملوكي عندما فصّل بين جيل الفضائل المملوكية الذين “كانوا حُكَماء يديِرون الأقاليم، وقادة يناضلون من أجل الله، وأهل سياسة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الخير، ويعينون الظالم من جار أو معتدي”. وبين جيل الأزمات والانحدار عندما “أصبحت المماليك الحاكمة الأكثر فسادًا، وأدناهم وأسفلهم من ناحية القيمة، وأقلهم إنسانيةً، وأجهلهم في شؤون الحياة، وأكثرهم تخلفًا في الدين، لم يكن فيهم إلا من هو أثقل من القرد، وأليف من الفأر، وأكثر إفسادًا من الذئب، لا عجب أن تدمر البلاد المصرية والشامية”!!
ويحلل المقريزي أسباب هذه الانتقالات في جيل المماليك -الذي كانوا قادة الدولة-، حيث يعزوها إلى التحول الذي حدث في نهج تعليم وتربية أبناء هؤلاء المماليك. في الجيل الذهبي منهم كان “المملوك” يتبع برنامج تأهيل شامل ومتكامل لتنمية مواهبه وقدراته بشكل متوازن، وفق نظام تعليمي وعسكري صارم كانوا يتبعونه في “قلعة الجبل” بالقاهرة، والذي كان يجمع بين الأخلاق الإسلامية والأدب والفنون والعلوم العسكرية والتربية الدينية.
كان يبدأ المملوك بتعلم “القرآن الكريم، وكان لديه فقيه شخصي يعلمه كل يوم، ويتعلم منه كتاب الله ويلمس فن الكتابة ويتدرب على أخلاقية الشريعة، ويحافظ على الصلوات والذكر…، فعندما ينضج أحد المماليك يتعلم من الفقيه شيئًا من الفقه، ويقضي وقته في تعلم فنون الحرب كالرماية والمبارزة وما شابه ذلك، مع مُعلِمٍ مختص حتى يصبح [الشاب المملوك] ما يجب أن يكون”.
وأثنى المقريزي على هذه الطريقة الناجحة التي تم اتباعها بصرامة تامة على مدار فترة المماليك البحرية الأولى في الدولة
(المقدم إلى برنامج دكتوراه في اللسانيات والترجمة [= الربيع)؛ فيقول: “ولا يصل [الشاب المسبي] هذا الدرجة إلا بعد أن تحسنت أخلاقه وازدادت أدبه، وتواجد تقدير الإسلامِ ومعينيه في قلبه، وتعززت قدرته في رمي الأسهم، وتحسّن لعبه بالرمح، وأصبح ماهراً في ركوب الخيل. وبعضهم يصبح محترفًا في مجال الفقه والمعرفة، أو شاعر أديب، أو محاسب ماهر”!
يلاحظ المقريزي نقطة التحول السلبي في أجيال المماليك عندما يحددها في لحظة صعود السلطان الظاهر بورقوق إلى الحكم بريادة انقلابية في القصر قادها ضد سادته من سلالة قلاوون، وبدء من ذلك الوقت، أصبحت المماليك تخلد إلى البطالة، وتنسى الفوائد السابقة، ثم توشك الأوضاع على الانهيار في عهد الناصر فرج بن بورقوق”، وذلك بعد أن “تبلور رأي الناصر في أن تسليم المماليك للفقيه سيدمّرهم، بل يجب أن يتركوا لأمورهم؛ فيتغير كل شيء تمامًا”!

اقتحام قانوني
في كتابه المليء «العبر والاستشهاد»؛ قدم تقي الدين المقريزي معلومات متميزة عن نظام العدالة في الدولة المملوكية، إضافة إلى أن ما قدمه يعدّ تحليلاً عميقاً لفهم التغييرات التشريعية والقانونية التي حدثت في ذلك النظام، وكانت محطًا لنظائرها التي ظهرت في التشريعات الحديثة لدينا، بدون فهم كامل لجذورها ومنشؤها البعيد.
لقد كتب المقريزي عن تفاصيل أول اقتحام قانوني وأنشأ منهجًا منهجيًا للقضاء الإسلامي الذي كان يحكم مجتمعاتنا الإسلامية منذ بدايتها، حتى شهدت حقبة حكم المماليك لمصر والشام نشأة أول قضاء يدير بـ”القانون الوضعي” ممثلًا في مدونة «الياسة» التشريعية المغولية، التي وضعها الجاسوس البلخي جنكيز خان (ت 624هـ/1227م)؛ فبعد أن “أصبحت له دولة حدد قواعد وعقوبات ثبتها في كتاب سماه «ياسة»، وكان الناس يطلقون عليها «يسق»”، وفقًا لما كتبه المقريزي.
وبعد غزو المغول للأقاليم الإسلامية وسقوطهم لبغداد في عام 656هـ/1254م ظهر قانون «الياسة/الياسق/اليسق» في ديار المسلمين عبر الإمارات التي أسسها المغول هناك، ثم اتخذ بعض السلاطين المماليك المتأخرين هذا القانون كنظام تشريعي موازٍ للقضاء الشرعي الإسلامي، فاستبقوا “القضاء المختلط” الذي جلبته -عدة قرون بعد ذلك- سلطات الاستعمار الغربي إلى مصر وغيرها من الأقطار الإسلامية؛ كما سنرى.
إدارة قانون “الياسة” المغولي أوجدت عقوبات كثيرة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحت مسمى “السياسة”، مثل “الجلد” و”التشهير” و”التشريد” و”التقسيم” الذي يتمثل في تقسيم جسد المعتدي إلى نصفين من الوسط.
وكان بعض حكّام المماليك يستخدمون هذه العقوبات الوضعية القاسية كوسيلة لتعزيز هيمنتهم الأمنية، ملقين اللوم على نظام العقوبات الجنائي الإسلامي بفقدان كفاءته في التوبيخ والردع، بسبب الضوابط والإجراءات الضامنة للعدالة للضحايا والمتهمين، والتي تشمل قيودًا تجعلها -في تقدير السلطة الاستبدادية- غير قادرة على تلبية احتياجات السيطرة الأمنية للسلطة الحاكمة، في حين يُسن لنظام العقوبات المغولي حرية التصرف دون شروط أو قيود وفقًا لـ “الياسة”، حسب المقريزي.
وحتى لا يمر هذا الاقتحام التشريعي الخطير من باب “السياسة” -أي وضع العقوبات التأديبية دون قيود من الشريعة- إلى الفكر القانوني الجماعي للأمة؛ فقد تجاوز الفقهاء مجرد رصد هذا الاقتحام وتحليل المنطق الكامن وراء اختراقه، بل قدموا بديلاً فقهيًا يعتمد على الاجتهادات التي تنبع من مرجعية الشريعة وتنظم بأهدافها وقواعدها.
وفعل ذلك عدد من كبار الفقهاء في تلك الفترة الذين قدموا اقتراحات مجددة لتعديل حالة المماليك؛ ابتداءً من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (ت 751هـ/1350م)، ومرورًا بالسبكي الشافعي وابن فرحون المالكي (ت 799هـ/1397م)، وانتهاءً بالمقريزي الشافعي وبدر الدين العيني الحنفي.
ويتيح هذا البديل لولي الأمر اتخاذ إجراءات عقابية تأديبية اجتهادية -أي تخلو من الدليل- شريطة الالتزام بالمرجعية الشرعية الإسلامية، وعدم تجاوز نظام العقوبات وفلسفتها التشريعية ضمن ما هو “مقبول في التأديب، وما تجاوز ذلك مرتبط بـ «السياسة»”؛ كما يقول الإمام العيني الحنفي.
ولكي نستوعب ما قدمه المقريزي في قصة هذا الاقتحام القانوني، نحتاج إلى عرض موجز للسياق التاريخي والفقهي الذي أدى بنا إلى تلك الوضعية التشريعية الغريبة التي استعرضها هو وغيره -من نجوم عصره- بشمول التفصيل، والذي يعيدنا إلى أن مصطلح “السياسة الشرعية” لا يعبر في مراجعنا التراثية -كما يتصوره معظمنا اليوم- عن “فقه الحكم”، بل يهدف إلى “السياسة” بمعناها الجنائي التأديبي والتقديري
عندما تتبع الأحكام الإسلامية بشكل صحيح، تصبح تلك السياسة “شرعية”، وليست “سياسة” تهدف إلى معاقبة السلطة دون قيود.
وهكذا يُظهر أحد أسباب تطور مصطلح “السياسة الشرعية” وتأصيله في العصر المملوكي -بالشكل الذي وصلنا إليه- كجزء من “الصراع المصطلحي” لتلك الأنظمة القانونية الجديدة التي جاءت من خلال تصوير “السياسة” الجنائية الفقهية، التي استخدمها الفقهاء -تبعًا لاصطلاح الأمراء والولاة- لوسائل إثبات الجرائم وللعقوبات التي تُفرض عليها، والتي أدخلها الحكام مستندين إلى ضرورة مواكبة تطور الجرائم (من حيث النوع والكم) وطرق ارتكابها في المجتمع.
وفقًا للإمام ابن عابدين الحنفي (ت 1252هـ/1836م) في كتابه ‘ردّ المحتار على الدر المختار‘؛ فإن للسياسة مفهومان يجب التمييز بينهما، “السياسة تهدف إلى تصحيح سلوك الناس بتوجيههم نحو الطريق الذي ينجيهم في الدنيا والآخرة..، وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة التي تشمل كل ما فرضه الله تعالى على عباده من الأحكام الشرعية. وتُستخدم [السياسة] بشكل أضيق من ذلك لتشمل شكلًا من أشكال العقوبة والتأديب، حتى لو تضمنت القتل، كما ظهر في قضايا اللواط والسرقة والقتل العمد إذا تكررت تلك الجرائم: يُجيز قتلهم تحت مسمى السياسة”.
ومن هذا المعنى الفقهي الخاص يظهر أن “«السياسة: شَرْعٌ مُغَلَّظ»، وتُقسم إلى نوعين: “سياسة ظالمة”: تحرمها الشريعة. و”سياسة عادلة”: تعبر عن حق الظالم وتحدث تغييرات إيجابية، وتحدُّ من الظلم، وتقاوم أصحاب الفساد، وتحقق الأهداف الشرعية؛ إذ تدفع الشريعة نحو هذا الطريق، وتعتمد على السياسة في إظهار الحق وتنفيذه، وتعتبرها بابًا واسعًا لأن “السياسة… تُسمح بها في كل جريمة، والقرار بشأنها يعود إلى الإمام (= السلطة)” في تقدير العقوبة حسب ظروف الجاني ونوع الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
ولا يُستبعد أن تكون رسالة “السياسة الشرعية في ترتيب العلاقة بين الحاكم والمواطن” -التي قدمها ابن تيمية لأحد الولاة فيليلة في عهد السلطان الناصر قلاوون (ت 741هـ/1340م)- بديلًا قانونيًا مرجعيًا لنظام “الياسة” الذي انتشر أيام المماليك. وابن تيمية استطاع تتبع الأسباب البعيدة لهذا التحول القانوني -الذي أدى إلى تقسيم شريعة مزدوجة أمهدت الطريق للتأثير القانوني المغولي- وقال في رسالته هذه:
“عندما تولّى أهل العباس (= العباسيين) الخلافة وحتمت عليهم ضرورة السياسة الناسية، وتولى القضاء لهم من فقهاء العراق (= المذهب الحنفي)، ولم يكن معهم ما يكفي من المعرفة في “السياسة العادلة”؛ استدعوا حينها إلى وضع “ولاية المظالم” وجعلوا “ولاية الحرب” غير “ولاية شرعية”، وتعقد الأمور في كثير من بقاع المسلمين حتى أصبح يقال: “الشريعة والسياسة”، وهذا يدعو خصومه إلى “الشريعة”، وهذا يدعو إلى “السياسة”، أوصى الحاكم بالحكم بحسب الشرع والآخر بالسياسة. والسبب في ذلك: إن الذين انضموا إلى “الشريعة” كانوا يلزمون أنفسهم من الإسفاف إلى السنن، فأدى ذلك إلى تفقيرهم لحقوق الناس وتعطيل الحدود، حتى باتت تسال الدماء وتستولى على المال ويتحول المحرمات إلى حلال! والذين انضموا إلى “السياسة” صاروا يسوسون برأي من دون اعتماد على الكتاب والسنة”!!
وأشار ابن تيمية إلى خطورة تأثير القانون المغولي -في عصره- على جوانب متعددة من حياة الناس، وأن هذا سيؤدي إلى تأثير نظام “الياسة” في البيئة الإسلامية؛ ولذلك، أصدر فتوى هامة لمواجهته حتى في درجة ضيقة مثل لعبة “الرماية بالبندقية”، وهي إحدى أنواع المنافسات الرياضية في صيد الطيور التي كانت تثير إعجاب أمراء المماليك، وكانوا يعينون “حُكَّامًا” لتنظيم تلك المنافسات وتضمينها في قواعد تسمونها “شرع البُندق” أو “حكم البُندق”، وقد قد تكون هذه القواعد غير متناسبة مع الضوابط الشرعية في المنافسات الرياضية.
فقد وُجِه إليه سؤال شرعي بخصوص الالتزام بـ”«شرع البُندق» الذي لم يشرعه الله ولا رسوله”؛ أجاب عليه -كما جاء في “مجموع الفتاوى”- أن “لا أحد يحق له أن يحكم بين الناس؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أو الفتيان (= جماعات الفتوة)، أو رماة البندق، أو الجيش، أو الفقراء (= الصوفية)، أو غيرهم: إلا بحكم الله ورسوله…؛ ومن حكم بـ”حكم البندق” و”شرع البندق” أو ما يخالف شريعة الله ورسوله -علمًا بذلك- فهو ممن يشبه التتار (= المغول) الذين يفضّلون حكم “الياسة” على حكم الله ورسوله، ومن يقوم بهذا عملًا يعرِّض نفسه للانتقاد في عدله ودينه، ويجب أن يمنع من التدخل في الوقف”، أي يمنع من إدارة وتسيير أموال الأوقاف…
أمام أي سبب للجوء إلى أي منشأ قانوني غير إسلامي، يظهر الرفض لدى هذا العالم للجوء إلى أية نظام عقابي خارج إطار الشريعة. وأكد على عدم وجود تعارض بين الشريعة و”الحكم العادل”، حيث أشار إلى وجود نوعين من الحكم: حكم ظالم يحظره الشريعة، وحكم عادل يقوم بإخراج الحق من الظالم الفاجر، وهو ما يمتدحه في كتابه ‘الأساليب الحكومية في السياسة الشرعية‘.

توغل منسق:
ثم جاء قاضي القضاة الشافعي تاج الدين السبكي ولاحظ -في كتابه ‘معيد النعم ومبيد النقم‘- انتشار هذه الظاهرة الغريبة في الأوساط الإدارية المملوكية، وتقديم نقد لبعض المسؤولين لتمسكهم بأحكام الجزاء الإسلامية، ووصف عقوباتها باللين مقارنة بنظام التخويف المتبع من قبل بعض أجهزة السلطات المملوكية بنظام “الياسة”. وفي هذا السياق، ينتقد السبكي تقديم النهج القانوني على حساب قواعد الشريعة قائلا:
“وبصفتهم (= الحكام ونوابهم) لهم الحق في تسليم شؤون الحكم للشريعة؛ لأنه لا يوجد حاكم سوى الله عز وجل، ولن تفعل العقول شيئا؛ إذا رأيتَ أحدهم ينتقد نائب السلطنة لانغماسه في الشريعة ويربط ذلك بـ التلطف والضعف، فاعلم أن لديه مخاوف من أن يكون من الذين طبعت قلوبهم، والعقاب له قاسي، بل يجب على كل مسلم أن يرضى بحكم الله تعالى ويذل نفسه، ومن لا يحكم بما أنزل الله فهؤلاء هم الفجار والكفار والظالمون”!!
ويجذب السبكي انتباهنا إلى مدى درجة التناول المصطلحي الذي وصلت إليه هذه الظاهرة القانونية، حتى بات غير ضروري تسميتها بلفظها المغولي “الياسة”، بل أصبحت مدرجة ضمن التراتيب الإدارية المحلية تحت اسم يتنافس مع الشريعة الإسلامية وهو: «شريعة الديوان»؛ لذا يستعرض السبكي بعض السياسات الانحرافية في نظام المؤسسة العسكرية المملوكية ثم يعلق قائلا:
“ومن يد القائمين (= مسؤولي ديوان الجيش) أنهم عندما يقررون اتباع شيء مما سبب عواقب قبيحة يقولون: هذا «شريعة الديوان»؛ وليس للديوان شريعة، بل الشريعة لله عز وجل ولرسوله ﷺ. فهذا الكلام يقود إلى الكفر؛ وإن لم ترتاح النفس لتكفير من يقوله فلا بد من معاقبته بالجلد حتى يكف عن هذا التمجيد الذي ليس في حاجة إليه بأن يقول: «عادة الديوان» أو منهجه، أو شيء من تلك العبارات التي لا يمكن رفضها”.
لقد تمحورت جهود تلك الأئمة وغيرهم حول محاربة الانتهاك القانوني الوضعي من خلال إيجاد بديل فقهي اجتهادي، وهكذا “صُنف الناس في «السياسة الشرعية» كتبا متنوعة”؛ وفقا لرؤية المقريزي الذي أبرز أهمية تحليله لهذه الظاهرة في تسجيلها -من خلال عدد من القضايا القضائية- لمراحل تسللها التاريخية التدريجية، والمستويات التي اخترقتها التدابير التنفيذية إلى حياة الناس العادية، مقدما بذلك نوعا من التأريخ لـ “علمنة قضائية” مبكرة في تاريخنا.
وما لفت الانتباه في رؤية المقريزي هو التساؤل حول “المرجعية” في هذا النظام القانوني الوافد، والتي تحمل منطلقات ومضامين ليست دينية ولا تسمح بالتوافق مع أي مرجعية متضادة؛ حيث ذكر أن “جنكزخان لم يعتنق دينا من أديان سماوية، وكانت تشريعاته متسقة مع الدين لأنه حين “مات اعتنق أبناؤه وأتباعه حكم “الياسة” كشرع أوائل المسلمين قبله محكم القرآن، وجعلوا ذلك دينا لم ينقل عن أحد منهم خلافه بوجه”.
ويظهر هذا التشريع بوصفه محايدًا أمام الأديان في صيغة مشابهة للعلمانيات المعاصرة، حيث يُلزم أتباعه “بتقدير جميع الديانات دون تحيز لدين على آخر”. ويسترشد المقريزي بأحكام من هذا القانون المغولي، مثبتا بذلك مخالفته لقاعدات الإسلام في عقوبات الجرائم، ومنطلقه في عرضه على حديث من أحد الشيوخ الثقات في عصره أم الله “رأى نسخة من «الياسة» في خزانة المدرسة المستنصرية في بغداد”!!
وبناء على تحليل المقريزي الذي قدمه في كتابه ‘المواعظ والاعتبار‘؛ فإن قصة هذا الانتقاق القانوني التشريعي هي قصة المماليك ذاتها وتطور دولهم في مصر والشام، حيث انتشروا من أقاليم الدول المغولية، “فزادت أرض مصر والشام بطوائف المغول، وانتشرت عاداتهم وأساليبهم، حيث ملأت قلوب ملوك مصر وأمراءها وقواتها الرعب من جنكزخان وأبنائه، وتأثروا بشخصياتهم وتقديروهم، وكونوا نصف عقلاء وتم تعليمهم القرآن وتعرفوا على أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمعوا بين الحق والباطل، وجمعوا الخير بالسوء”!!
يشير إلى بادئ الأمر لهذا الانتهاك القانوني عبر قوله: “أعلم أن الناس حاليًا – ومنذ فترة السلطنة العثمانية في مصر وسوريا – يرىون أن الأحكام تنقسم إلى “حكم ديني” و “حكم سياسي”!! بينما يذكر تلميذه المؤرخ ابن تَغْري بردي بدقة أكثر في “النجوم الزاهرة” أن “الملك الظاهر [بَيْبَرْس البُنْدُقْداري (ت 676هـ/1277م)]… كان يتبع قواعد حكام جنكزخان من قضية “اليسق”!!
في البداية؛ كان هذا الانتهاك القانوني مقتصرًا على بعض أقسام النخبة الحاكمة من خلال منصب “الحجب” أو “الحجوبية”، الذي كان يشغله مسؤول في المرتبة الثالثة في البلاط المملوكي يُسمى “الحاجب”، وكانت هذه الوظيفة تشبه ما يُعرف اليوم بـ “القضاء الإداري العسكري” لأن مهمته “حسبه أن ينصف (= يقضي) بين الأمراء والجنود” لحل النزاعات الإدارية بينهم، و “يتدخل لفصل المظالم بين المتنازعين وخاصة فيما لا تُبرر دعوى المسائل الإدارية وما شابه”؛ وفقًا للقلقشندي في “صبح الأعشى”.
ويوضح المقريزي التحول الذي حدث في جوهر عمل “الحاجب” – أثناء فترة الدولة المملوكية – من وظيفة بلاطية بروتوكولية إلى وظيفة قضائية بطبيعتها؛ حيث يقول إن أوائل السلاطين والأمراء المماليك “فُوِّض القاضي الأعظم ما يتعلق بالأمور الدينية.. ووُكل إليه النظر في الدعاوى الشرعية..، واحتاجوا أنفسهم إلى الالتماس عادة جنكزخان والاقتداء بتقاليده [القانونية] “الياسة”؛ لذلك عيَّنوا الحاجب ليحكم بينهم فيما خلافوا فيه من أمورهم.. بحسب ما جاء في “الياسة”…؛ لقد شرّعوا في “الديوان” ما لم يُباح به الله تعالى” وتعارضوا مع أحكام الإسلام!!
وهكذا، وجدت أول تقسيم قانوني وقضائي – في تاريخ الدولة الإسلامية – طريقها إلى المحكمة الشرعية، وبالرغم من بقائها مقيدة في نخبة الطبقة الحاكمة، “إذ لا يتجاوز حُكم الحاجب النظر في النزاعات بين الجند واختلافهم في قضايا التجزئة والمشابهات، ولم يكن أحد من الحجاب بالسابق يحاكم في أمور شرعية، مثل قضايا الزواج والديون، لكن هذا يعود إلى قضاة الشريعة”.
وبينما استمر حُكم الشريعة في حكم المجال العام – دون تدخل في سلطانه – لمدة تقترب من قرن كامل، يشير المقريزي إلى لحظة التحول الأكثر خطورة في مسار هذا الانتهاك القانوني، الذي سينقله من دائرة التعامل الضيق إلى المجال العام، حيث يصبح جزءًا من نظام القضاء العام وأحد مستويات المحاكمة بين جميع طبقات المجتمع.
إذ يسجل أن البداية الفعلية لهذا التحول – برغم المحاولات السابقة التي لم تستمر – كانت في عهد السلطان صالح بن محمد بن قلاوون (ت 762هـ/1361م)؛ حيث في ربيع الأول من سنة 753هـ/1352م “تم تكليف الأمير جرجي (= سيف الدين جرجي الإدريسي الذي توفى 772هـ/1370م) بوظيفة “الحاجب” للحسم في قضايا الديون وإصدار الأحكام بناءً على “السياسة”، ولم يكن عادة الحجب – كما تقدم السؤال – أن يعلنوا أحكاما في القضايا الشرعية”!!
ولم يكن ذلك القرار الخطير إلا البداية الحقيقية للتوسع الأفقي الذي استمره انتهاك القانون “الياسة” الوضعي على حساب القضاء الشرعي؛ حيث “أصبح “الحاجب”… اسمًا لجماعة من الأمراء الذين ينصبون أنفسهم لحكم الناس… يستفيدون من مظالم العبيد، وأصبح “الحاجب” اليوم يصدر أحكامًا في جميع قضايا الناس، سواء كانت الأحكام شرعية أم سياسية حسب زعمهم…، وكانت أحكام الحجب يُطلق عليها أولًا “حُكم سياسي”…، ويقولون: هذا الأمر لا يتوافق مع “الأحكام الشرعية”، وإنما هو من “حكم السياسة”؛ يرونه سهلًا ولكنه عظيم عند الله”!!
يروي المقريزي أن التحريف اللفظي الذي حدث لكلمة “الياسة” ساهم في تأييد هذا الانتهاك القانوني اجتماعيًا، حيث أصبح الناس ينطقونها “سياسة” دون إدراك، مما جمع بينها وبين “السياسة” بالمفهوم الفقهي الجنائي الذي شرحناه. على الرغم من أن الياسة “كلمة مُغُلية أصلها: “ياسه”، حيث أضافها أهل مصر وزادوا على أولها سينا ليقولوا: “سياسة”، وأضافوا عليها الألف واللام، ليرى من ليس لديه معرفة بأنها كلمة عربية، وأن ما فيها ليس سوى ما ذكرته له”. بعد ذلك، قام المقريزي بالكشف عن “كيف نشأت هذه الكلمة وانتشرت في مصر وسوريا”!!
ويزداد وضوحًا لتفسير اللفظ اللغوي الذي قدمه المقريزي أن ابن تَغْري بردي – الذي هو من أصل تركي وماهر في لغته الأم – وافقه في ذلك، حيث شرح المصطلح بشكل أفضل مما فعل معلمه؛ فقال – في كتابه “النجوم الزاهرة” – أن جنكيزخان “هو صاحب “التورا” “واليسق”…، والتورا باللغة التركية تعني: المذهب، واليسق تعني: الترتيب. وأصل كلمة اليسق: “سي يسا”، وهي كلمة مركبة من لغة أعجمية وتركية، ومعناها: التراتيب الثلاث؛ لأن “سى” باللغة الفارسية: ثلاثة، و “يسا” بالتركية: الترتيب”!!
ثم أكد ابن تغري بردي على النتيجة التي توص
الملاكمة بعناية بخصوصانتشار نبذة اللفظ في خطاب الجمهور بإستعماله المعربة، حيث يوضح: “ووفقا /اللفظ/ لوساع الأيام لتتطور التتار من الأمس حتى اليومنا هذا، وتنتشر هذه العادة في جميع الإمبراطوريات حتى الممالك مثل مصر والشام، وأصبحوا يقولون: «سى يسا»، فتأثرت عليهم وقالوا: «سياسة» على تحاريف آبناء العرب بلغات الأزلام”!!

معارضة فقهائية
رغم تغير الحال؛ ظلّ حَرَم القضاء الشرعي إلى حدٍ بعيد مكانًا تلجأ الأمة إليه عند ابتعاد وتفلت محاكم «الياسة» العسكرية المملوكية؛ وفي هذا يعلق المقريزي: “وكانت لدينا دائمًا العلم أن أي شخص من الكُتّاب أو الكفيلين إلى آخرهم يهرب من أمام القاضي العسكري ويتجه نحو أحد القضاة ويتيقن بـ«حُكم الشرع»، فلا ينتظر أحد بعدها في استلامه من عند القاضي، وكان بينهم من وقف الشهور والسنوات في تأييد (= حماية) القاضي حفاظًا عليه من مخالفي الحُجّاب”!!
ويخبرنا المقريزي بأن كبار العلماء والقضاة الشرعيين استمروا في انتقاد تدخّل هذه المحاكم الإدارية العسكرية الوضعية في فعالية القضاء الشرعي، وتجهّموا إلى ألغاء العمل بها وإن لم يحققوا هدفهم بشكل دائم.
حدث في جمادى الآخرة سنة 823هـ/1420م -في زمن قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البُلْقَينِي (ت 824هـ/1421م)- أن صدر أمر سلطاني يفرض “عدم المحادثة في الأمور الشرعية إلا من قبل القضاة، وعدم يجوز لأحد شكوى غريمه في ضد أحد من الحُجّاب…، حاول الأمراء في تحطيم ذلك حتى نادوا… بعد يومين بعَودة الحُكم إلى الحُجّاب” كما كانت قبل إبرام القرار؛ بحسب ما رواه المقريزي في كتابه ‘السلوك‘.
وقد أوردنا سابقا تعريف “السياسة” -بهذا المفهوم- كما نص عليه الإمام ابن عابدين نهاية فقهاء الحنفية، وجملته أن “السياسة: شَرْعٌ مُغَلَّظ”، ولذلك فهي “قانونية في كل جناية، واختيارها يرتبط بالإمام (= السلطة)” من حيث تقدير العقوبة اعتمادًا على طبيعة الجناية والجاني، وبناء عليه فإنها إذا كانت “سياسة عادلة تُزيل الظلم، وتقلل الجرائم، وترهب فاسدين، وتحقق الأهداف الشرعية؛ فالشريعة تلزم الاستمرار معها والاعتماد في دعم الحق عليها، وهي فرصة واسعة”.
وفي هذا السياق الفقهي الآن؛ أقام محمد علي باشا -مدفوعًا برغبة السيطرة والحكم الصارم المميزة لحقبته- نظامًا قضائيًا يتمحور حول “مجالس الأحكام” التي جرت في المحافظات، لكن يبدو أن عمل هذه المجالس ظل -بشكل عام- مشروطًا بالمعايير الشرعية الإسلامية؛ لأن نظامها القضائي كان مبنيًا على التوسع الذي تبناه عدد من الفقهاء في مفهوم “البينات الشرعية” المطلوبة لتثبت الجرائم، وكذلك التوسع في “جزاء التعزير” المطلوب لمحاربتها.
ولعل من الأسباب التي دفعت محمد علي إلى تبني نظام “مجالس الأحكام” هو أن المذهب الحنفي -الذي اعتمده في محاكم الدولة العثمانية التي كانت مصر واحدة من ولاياتها حينذاك- يقضي بأن المفهومين “«السياسة» و«التعزير» متجانسان، ولذلك تصلبا إحدى على الأخر لشرح التفسير”؛ بالاقتران بما أفقهه ابن عابدين الحنفي -في كتابه ‘ردّ المحتار‘- فحدد أنه في مذهبه ينظر “إلى باب التعزير هو المسؤول لأحكام السياسة”.
وكذلك بأن الأدلة على إثبات الجرائم غير مقيدة عند المحققين من الفقهاء في عدد محدد أو نوع معين؛ وفي فأدلة هذا الأمر شرح ابن القيم كتابه الشامل ‘الطُّرُق الحُكْمية في السياسة الشرعية‘، الذي يقول فيه “إذا ظهرت علامات العدالة وجاءت وجوهًا بيضاء -بأي
الطريق الذي كان فثمة شرع الله ودينه”، وبناءً على ذلك “الشارع لم يُبطل القرائن والعلامات والمؤشرات الخاصة بالحالات، بل من استنبط الشرع -من مصادره وموارده- وجد أنها تُشير إليه بكل اعتبار، مُرْتَبِطة به حُكَماء” شرعية، سواء كانت عقوبات محددة -مثل الحدود والقصاص- أو جزاءات تتبع نهج اجتهادي يرتبط تقديرها بالسلطات القضائية.
وقد توجه بعض الخبراء القانونيين المصريين انتقادًا لهذا النظام القضائي مثل أحمد فتحي باشا زغلول (ت 1332هـ/1914م) في كتابه “المحاماة”؛ إذ كانت العقوبات المُفروضة على المخالفين الذين يحاكمهم هذه المحاكم في الجرائم والجنايات التي يُتّهمون بها، تُفضي إلى شدة غير مسبوقة.
وهذا الانتقاد يشبه إلى حد كبير الانتقاد الذي وجهه ابن تيمية والسبكي والمقريزي لنظام “الحُجُوبية” المملوكي؛ فالسياسة العادلة -بغض النظر عن اجراءاتها وقوانينها- هي التي تُعتبر جزءاً من شرع الله تعالى، أما الظلم فيُمسح بالشرعية عن قضاة “السياسة” الظالمة فحسب، بل يُزيلها حتى على الدولة الإسلامية القمعية. وكان أحمد فتحي ناجحا في تجديد هذه النهج الراسخ في انتقاد نظام “مجالس الأحكام” الذي تسيّسه القسوة والظلم في التنفيذ العملي، مهما كانت أهداف السلطة حينها خلف إقامتها.
والحقيقة أن الاختراق التشريعي المُعاصر الأكثر خطورة -من حيث البُعد التشريعي المتعلق بشخصية الأمة والدولة- هو الذي وقع بعد نهاية عهد محمد علي، وتم اعتماد القانون الفرنسي كمرجع للحكم في النظام القضائي المصري. ومصدر خطورة هذا الأمر هو أنه يُشبه إلى حد كبير تبني القانون المغولي “الياسة” من قديم الزمان في البيئة التشريعية المصرية، وبطريقة تدريجية يُذكِّرنا أيضا بنمط تأسلس “الياسة” وتأقلمها في الحياة العامة!!
فمن الملاحظ أن غرس النظامين الأجنبيين تم عن طريق مساريْن مشابهيْن: الأول هو “تضاعفية القضاء” التي تمثّلت في القضاء العسكري المملوكي الذي كان يُحكم في نزاعات قادة الجيوش وجنودهم، ووفقًا لنظام “الحُجوبية”. وفي الزمن الحديث انعكست هذه التضاعفية القضائية في “المحاكم المختلطة” التي تم تأسيسها في مصر خلال 1292-1369هـ/1875-1949م ليتم فصلها في القضايا التي يكون فيها الرعايا الأوروبيون طرفاً، وتمتلك في هيئاتها قضاة مصريين وأوروبيين.
والمسار الثاني الأكثر تأثيرًا هو: وجود نُخب سياسية وقضائية معاصرة في مصر وغيرها، امتصت المنهج القانوني الغربي حتى “تمزج مع جلدهم ودمهم”؛ على غرار وصف المقريزي لحال النخبة المملوكية الحاكمة في إعجابها بالقانون المغولي!!

تأريخ للأفكار
كتب المقريزي شبكة واسعة من الأفكار والعبارات، وحتى من الأنظمة الإدارية والمؤسسية التي لم يمنعه ضيق المكان من استعراض نماذج من تأريخها وتطورها. تسعى كتاباته في كل ذلك إلى تقديم إطارات نظرية ومفاهيم تفسيرية لمسائل تتعلق بالمذاهب والتيارات والأديان أو الدول والمجتمعات والمؤسسات، وتوثق التغييرات السياسية والاجتماعية والإدارية التي تصاحبها ضمن سياقات الحضارة الإسلامية، وتكشف عن لحظات نشوئها وظروف انتشارها وترسيخها وعوامل استمرارها أو اضمحلالها.
وكان أسلوبه المثالي في تقديم كل ذلك -بشكل تاريخي وتحليلي ومُنْهَجي- هو الرويات والآثار وما يتعلق بذلك من “طبائع العمران” وفق تعبير شيخه ابن خلدون. وتفتخر المقريزي بتعقُّب الحقائق والبحث عن جوهرها بنفسه بالطريقة التي يشير إليها في كتابه ‘السلوك‘: “أعتادتي في استطلاع أحوال العالم”!! وتطبق اهتمامه بالمشاهدة الميدانية والملاحظة الشخصية للأحداث والوقائع كان لها أهمية كبيرة حيث أنشأ مصنفًا يبدو أنه لم يوصل إلينا، فالسخاوي يُخبرنا أن المقريزي “حفظ كتابا عن ما شاهده وسمعه مما لم ينقله من كتب”.
وهذا الشغف المتعدد المنهجي والمصادر البحثية هو ما جعل المقريزي يُعرَف بـ”اجتهاده واصراره وتعدد أهدافه، وعنايته بوجوه التأريخ التي تميل نحو الجمع والإحصاء”؛ وفقًا للمستشرق البريطاني هاملتون جِبْ (ت 1391هـ/1971م) في مادة “تأريخ” التي نُشرت في كتاب ‘موجز دائرة المعارف الإسلامية‘.
وبهذه المقدمة يتضح الكثير عن قواعد الفكر والأنظمةإن مشكلة التسيير تكمن في بعض الأحيان في عدم توفير النتائج المعرفية بشكل محدد مسبقًا، بل يتطلب من الباحث التأمل في تفاصيل وأبعاد تلك السرد، والكشف عن الحمولات والاستنتاجات المذكورة فيه، وما يشير إليه اختيارها من بين مجموعة من الرموز أو يثير منها من تساؤلات.
ويجب أيضًا أن ندرك أن كل إصدارات المقريزي لها منهجها الخاص في التعامل مع الروايات؛ فالكتب السيرية، مثل “المقفى” أو “السلوك”، تختلف عن كتاب “الخطط” ذي الجوانب الموسوعية المتنوعة، أو عن كتب النقد أو “دراسات الحالات” كـ “إغاثة الأمة” و”النزاع والتخاصم”.
على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى موقفه من مذهب المدرسة الحنبلية كما ورد في كتابه “المقفى” بمفرده، سنجد أن المقريزي كان يؤيد بشدة شيخه ابن تيمية، وإذا أضفنا له ما ذكره عنه في “الخطط” سيكون في موقع الملاحظ الناقد، وإذا بحثنا عن تأثيره في تأملاته وأحكامه سيصبح في موضع المتأثر المبدع.
وكذلك تطرق إلى علاقته مع شيخه ابن خلدون؛ فإشارته المباشرة له في الروايات لا تعكس إطلاقًا سعة وعمق القوانين الخلدونية التي تملأ كتاباته معلنةً فيها أو مستترةً، ويمكن القول إن المقريزي يتذكر “المقدمة” الخلدونية في كل فصل يكتبه أو عنوان يضعه أو حادث يسجله، حتى إن لم يذكرها مباشرة في بعض الأحيان.
لقد أدرج نموذجها المعرفي على سبيل المثال في معالجته لموضوعين ناقشناهما سابقًا، وهما: مسألة “نسب الفاطميين” في “اتعاظ الحنفاء”، ومعالجته ل”أخلاق المصريين” في “الخطط”. وقد يكون السبب في ذلك الحاجة إلى قاعدة ومصدر كبير يدعم ما يقدمه من مباحث في هذين الأمرين المثيرين للجدل.
عندما يُعين المقريزي للفكر الإسلامي، فإنه يُعين له بطريقة مماثلة كما يفعل مع أي موضوع تاريخي آخر، أي بالنظر إليه على أنه سلسلة من الأحداث تسهم في ظهور وتطوير فكرة معينة، كما عيّن نقطة انطلاق الفكر الإسلامي وظهور المعارف ببداية حركة الفتوح الإسلامية التي نقل بها الصحابة من المدينة إلى البلاد، مما أدى إلى تفاعلات متنوعة وتنوع في الرؤى، ضمن إطار من التكامل والتحقق المشترك من الروايات والآثار النبوية، مع وجود اختلاف وتباين في الفهم والتطبيق، وظلت تلك السمات من سمات الفكر الإسلامي وعناصر قوته.
وقد استكشف المقريزي في “المواعظ والاعتبار” هذا النشاط العلمي منذ زمن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما؛ حيث أشار إلى تفرق الصحابة في تلقي العلم عن النبي، مما أدى إلى انتشار وتطبيق ما تلقوه من روايات نبوية، قد لا تكون متاحة في بلدان أخرى.
ونتيجة لهذا التطور المعرفي نشأت طبقة “التابعين” الذين استمدوا هذه الروايات من جيل الصحابة، ولم يتجاوزوا في اجتهادهم ما تلقوه عن الصحابة في بلدانهم، كما استمد جيل الفقهاء من التلامذة للتابعين الذين زادوا في اجتهادهم بناءً على هذه النصوص والروايات.
وأسس هؤلاء العلماء لعدد من المذاهب الفقهية التي اندثرت اليوم.
في سياق الحياة العملية “استكتفوا على تلك الطريق بأخذ كل واحد منهم عن التابعين من سكان مسقط رأسه فيما كان لديهم، واستندوا فيما لم يجدوه عندهم على جهودهم الشخصية والذي يتوفّر لدي غيرهم”.

تعدد الفروع
وربما كشف هذا التحقيق حول الاندفاعة الأولى التي قام بها المقريزي عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهور التباينات الفقهية، وتوضيح أسباب تعدد هذه التيارات، وأن تشكلها وانحدار بعضها عن بعض كان طبيعيًا في العموم، ولم يكن دائمًا نتيجة لسلطة سياسية أو اجتماع ديني يقبل أو يعارض، بل كانت بالفعل نتيجة لتحركات الصحابة، واستقبال التابعين، وجهود الفقهاء.
بظهور الفقيه انطلقت العلوم التي تمتدح حول الأحاديث النبوية وتوثيقها، وكانت أول من قام بذلك محمد بن شهاب الزُهري (ت 124هـ/743م)، وأول من كتب وصنف بسعيد بن [أبي] عَرُوبة (ت 156هـ/775م) والربيع بن صبيح (ت 160هـ/778م) في البصرة، ومعمر بن راشد (ت 153هـ/772م) في اليمن، وابن جُرَيْج في مكة، ثم سفيان الثوري في الكوفة، وحماد بن سلمة (ت 167هـ/784م) في البصرة، والوليد بن مسلم (ت 195هـ/811م) في الشام، وجرير بن عبد الحميد في الري (ت 188هـ/804م)، وعبد الله بن المبارك (ت 181هـ/797م) في مرو وخراسان، وهُشَيم بن بشير (ت 183هـ/799م) في واسط، وتميز بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235هـ/849م) بكثرة الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف”.
مع ظهور المعارف الشرعية بدأت ظهور بعض الظواهر الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة. لقد رصد المقريزي تنامي الطبقات العلمية للموالي وصعودهم الاجتماعي والثقافي بسبب تميزهم المعرفي وتفوّقهم العلمي، وقد كان هذا الموضوع محل اهتمام من بعض النخب العربية التي شهدته، إذ “انكر العرب ذلك (= تفوّق الموالي)، فقال [الخليفة] عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ/720م): «لم أذنب إذا كانت الموالي يتقدمون بأنفسهم وأنتم لا تتقدمون؟!»”.
وفيما يتعلق بمصر وعلاقتها بهذا السياق؛ فإن المقريزي يلفت الانتباه إلى فكرة مدهشة، وهي أن الإمام التابعي “يزيد بن أبي حبيب (النوبي المتوفى 128هـ/146م) كان أول من نشر المعرفة في مصر بخصوص الشرع واللوائح… ومسائل الفقه، وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الفتن والترغيب”!! وربما تعكس هذه القصة قدمًا التقليدية للمصريين في الحكايات والعجائب والروايات الشهيرة، وهو سلوك يظل متأصلا في الهوية المصرية حتى يومنا هذا!!
ثم أشار المقريزي إلى أمر آخر يتعلق بتاريخ تشكّل الهوى السياسي المصري، وهو قول يزيد هذا: “ترعرعت في مصر وهي عَلَوية (= شيعة علي) فتحلَّت بها عثمانيةً (= الأمويون)”!! والغريب في هذا الأمر أنه مع ظهور هاتين الفرقتين المتضادتين (العلوية والعثمانية) ظهرت جماعة “الخوارج” بقوة في مصر.
وعندما أعلن عبد الله بن الزبير (ت 73هـ/693م) توليه الخلافة متنافسًا عليها يزيد بن معاوية (ت 64هـ/684م)؛ دعمه بعض “الخوارج” معتقدين أنهم على مبدأهم، وفي سنة 64هـ/685م “أرسل [ابن الزبير] إلى مصر بعبد الرحمن بن جَحْدَم الفِهْري (ت بعد 65هـ/686م) فوجدها في طائفة من الخوارج…، فتكاثر الخوارج في مصر من بينهم ومن قدموا من مكة، فظهروا في مصر «بالتحريض» ودَعوا إليه”. و”التحريض” هو العقيدة السياسية للخوارج التي تقوم على مبدأ “لا حُكْم إلا لله تعالى”.
ونتيجة لتصرف ابن الزبير هذا، تغيرت الوضعية السياسية في البلاد “فأصبح سكان مصر حينها ثلاث فئات: علوية وعثمانية وخوارج”؛ فعندما تم تنصيب مروان بن الحَكَم الأموي (ت 65هـ/686م) للخلافة في الشام أرسل جيشًا لمواجهتهم سنة 64هـ/685م، وهزموهم “ومنذ ذلك الوقت تفوّقت العثمانية (= الأمويون) في مصر، وانحرفت كلمة العلوية والخوارج”.
ثم تناول المقريزي ظاهرة الرحلات العلمية التي بدأت تظهر في الأقاليم مع بداية نشاط تجميع الآثار المتفرقة بين علمائها، حيث انتشر علماء كل منطقة للبحث عن المفقود من الروايات المجهولة في بلدانهم.
الرحلة نحو المدافع، وتقاطع الأفراد والترابُط، واستقدام مجموعات لتجميع الحديث النبوي وتسديده”.
كانت مصر تحتسب قسطها من تلك الرحلات العلمية ليصبح أبو سعيد عثمان بن عتيق الغافقي (ت 184هـ/800م) “أوّل من رحل من أهل مصر إلى العراق بحثاً عن الحديث”. وفيما يتعلق بالسَنَد القرآني، فقد كان أبا ميسرة عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي (ت 188هـ/804م) “أول من أقرأ بمصر بحرف نافعٍ (= أبو رُوَيْم نافع بن عبد الرحمن المدني المتوفي 170هـ/786م) قبل مرور مائة وخمسين سنة (150هـ/768م)”.
أفرزت نتائج سنوات من تلك الرحلات العلمية حصادًا وافرًا من المرويات والآثار “حيث وصلت أحاديث رسول الله ﷺ من البلدان البعيدة إلى من لم يكن لديه معلومات عنها، وثبتت الحجة على من توصل إليه شيء منها، وجُمعت الأحاديث الموضحة لصحة تفسير من التأويلات المستوحاة من الأحاديث، وتميز الصحيح عن الزائف، وتم إفساح المجال للاجتهاد الذي يؤدي إلى خلاف كلام رسول الله ﷺ وتاركًا لعمله، وتقديم العذر عند خلافه لما وصلته من السنن بوصوله إليه وتوجيه الحجة إليه”.
قد يكشف هذا النص مرة أخرى عن الانبهار الشديد للمقريزي بابن تيمية ومدرسته الحديثية التي ظل صاحبنا مخلصًا لها، حيث كانت حاضرة في تاريخه للأفكار، مبديًا عمق التأثير الأثري في شخصيته.
بالمثل، قدَّم المقريزي تفسيرًا لأسباب انتشار المذاهب الفقهية اجتماعيًا، مظهرًا -هذه المرة- ميوله الظاهرية عندما تبنى رأي ابن حزم الأندلسي في هذا الموضوع، حتى نقل بعض عباراته فيه بحرفية من كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم.
ربط المقريزي -في الخطب والمراجع‘- اتساع بعض المذاهب في إقليم ما بتبوُّؤ أحد فقهائها مرجعية الفتوى العامة، أو تسلّمه منصب “قاضي القضاة” (وزارة العدل) نظرًا لأنه أهم المواقع العلمية الصلبة بالسلطة الحاكمة. وأورد لذلك مثلاً بمذهبيْن هما أقدم المذاهب الفقهية السنية نشأةً، وبأمثلة من انتشارهما شرقًا وغربًا.
وقد أشهر المقريزي بداية هذه الحالة بتولي هارون الرشيد (ت 193هـ/809م) العرش العباسي في بغداد؛ حيث كان من بين أهم قراراته تلك التي تسببت في انتشار المذهب الحنفي، عندما “اتسمك لقضاء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ/798م) – أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى- بعد مرور 70 ومئة سنة (170هـ/786م)، فلم يقلِّد في بلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أحياه القاضي أبو يوسف رحمه الله واهتم به”!!
وفي الغرب الإسلامي وبالضبط في بلاد الأندلس؛ كان وراء انتشار المذهب المالكي هناك ما حققه الكبير فقهاء المالكية بالأندلس يحيى بن يحيى الليثي المصمودي (ت 234هـ/848م) من مكانه العلمية والاجتماعية؛ حيث بعد دراسته في المشرق مع الإمام مالك ورؤوساء تلاميذه “عاد إلى الأندلس فحصد من الرياسة والمكانة ما لم يحصل عليه آخرون، وعاد الفتيا إليه، وتجمعت عليه الحاكمون (= الأمراء الأمويون) والجماعة، فلم يقلَّد في كافة أعمال الأندلس قاضٍ إلا بإشارته واهتمامه، حتى أصبح أهل الأندلس على مذهب مالك”!! وتكررت القصة في تونس ومحيطها “عندما تولى سُحنون بن سعيد التَّنوخي (ت 240هـ/855م) قضاء إفريقية، بعد ذلك نشر فيهم مذهب مالك وأصبح قضاء أهل سُحنون دُولًا”.
وأثناء حديثه عن كيفية انتشار المذاهب الفقهية وعلاقتها بالقضاء، ركز المقريزي على ظاهرة الانقسام الفقهي وما يرتبط به من تعصب مذهبي وفتن تصل أحيانًا إلى النزاع المسلح بين أتباع هذه المذاهب، على الرغم من تعلق جميعها بمعسكر “أهل السنة والجماعة”، وبالحالة التلامذية المتوارثة بين أئمتها المؤسسين لها.
وانتشرت تلك الفتن المذهبية في المناطق المجاورة بين هذه المذاهب في الجغرافيا الإسلامية؛ مما أدى إلى استبدال قاضٍ بآخر من مذهب مختلف يعني ارتقاء علمائه وتأكيد مذهبه، وانفعال طلاب العلم على تعلم مسائله، وكان هذا وقودًا دائمًا لهذه الفتن الحزينة.
وأورد المقريزي مثالًا على ذلك بين الحنفية والشافعية في خراسان؛ حيث عندما تولى إمام الشافعية في بغداد أبا حامد الاسفراييني (ت 406هـ/1016م) “عندما تمكن من الدولة في أيام الخليفة القادر بالله (العباسي المتوفى 422هـ/1032م)… قرر تعيين أبو العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي (ت بعد 391هـ/1004م) بدلاً من أبي محمد ابن الأكفاني الحنفي (عبد الله بن محمد ابن الأكفاني المتوفى 405هـ/1015م) قاضي بغداد (= قاضي القضاة)، فرُد عليه بعدم رضى الأكفاني. وكتب أبو حامد إلى السلطان محمود بن سُبُكْتِكِين (محمود الغزنوي المتوفى 421هـ/1031م) وأهل خراسان حول نقل القضاء (= منصب قاضي القضاة) من الحنفية إلى الشافعية، وتعود ذلك بشهرة في خراسان وأصبح أهل بغداد عصبين”!!

الاختلاف الديني
وفيما يتعلق بمصر؛ فإنها رغم أنها لم تتجاوز -عموماً- تلك القاعدة الحاسمة في شرح انتشار المدارس الفقهية، إلا أنه يمكن القول إن الاختلاف الديني كان سمة من سماتها في معظم فترات تاريخها، مع وجود قوي وثابت لمدرستي الإمامين مالك والشافعي (ت 204هـ/819م)؛ فقد كان “مدرسة مالك ومدرسة الشافعي رحمهما الله تعالى هي التي تُتبعها أهل مصر، وكانوا يحكمون بموجبهما من يلتجئ إليهم أو إلى مدرسة أبو حنيفة رحمه الله” التي كانت تظل حاضرة في البلاد منذ دخولها عندما قام القاضي العراقي إسماعيل بن اليسع (ت 167هـ/783م) بإدخالها، وكان بذلك “أول من أدخل مذهب أبو حنيفة مصر.. وكانوا لا يعرفونه”؛ كما ذكر في كتاب ‘رفْع الإصْر‘ لابن حجر.
بقيت الهيمنة في مصر لهذه المدارس السنية الثلاثة -مع اختلاف في حجم الانتشار- حتى ظهور الدولة الفاطمية “ومنذ ذلك الحين انتشرت في بيوت مصر مذهب الشيعة، واعتُمد في القضاء والفتوى ورُفِض كل ما يعارضه، ولم يبقى مذهب سواه، وكان التشيع معروفًا في أرض مصر قبل ذلك”؛ حسب المقريزي في ‘المواعظ والاعتبار‘.
لم تُغير الدولة الفاطمية القاعدة العامة للاحتكار الطائفي بعض القرارات المحدودة زمنياً، التي أتاحت لبعض وزراءها بتبني تعدد المذاهب في مجال القضاء بشكل خاص، كما حدث في سنة 524هـ/1130م حين تم تعيين “أربعة قضاة: اثنان منهم إمامية (= الشيعة الإثنا عشرية) والآخران إسماعيلية (= شيعة فاطميون)، واثنان منهم مالكية وشافعية، فحُكم كل منهم بمذهبه وورث عليه بناءً على ذلك”.
عندما سقطت الدولة الفاطمية بيد صلاح الدين الأيوبي في جمادى الآخرة 564هـ/1169م “بدأ في تغيير الدولة وتنظيمها…، وأقال قضاة مصر الشيعة جميعاً، وأعفى القضاء (= منصب رئيس القضاة) لصدر الدين عبد الملك بن دِرْبَاس الماراني الشافعي (ت 605هـ/1208م) فلم يُعين من خارج المذهب الشافعي، وبدأ الناس منذ ذلك الحين بالتمسك بمذهب مالك والشافعي، واختفى مذهب الشيعة الإسماعيلية والإمامية (= الشيعة الإثنا عشرية) حتى اختفى تماماً من أرض مصر”.
وفي إطار الاختيارات الفكرية؛ يمثل المقريزي مراجعة تاريخية موجزة لظهور الفروق العقائدية وانتشارها وتعاقبها في الهيمنة والسيطرة، لاسيما في مصر والشام؛ ليبرز أن صلاح الدين هو من رسخ مدرسة الأشعري حتى تم تحقيق سيطرتها بشكل خاص في أقاليم الدولة الأيوبية، بعد أن فرض الفاطميون مبادئهم العقائدية خلال فترة حكمهم، وبالتالي كان من المتوقع أن تكون المواجهة على نفس النمط مسارًا ونتيجةً.
في هذا السياق، قال المقريزي: “وفيما يتعلق بالعقائد، فقد اتبع السلطان صلاح الدين عقيدة الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 324هـ/936م) الذي كان تلميذًا لأبي علي الجُبّائي (محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة بالبصرة المتوفى 303هـ/915م)، وكانت هذه العقيدة شرطًا في وقفياته التي في بيوت مصر…؛ وبقيت الأمور على عقيدة الأشعري في مصر والشام والحجاز واليمن، وكذلك في المغرب لنقل رأي الأشعري إليها مباشرة عن طريق محمد بن تُومَرْتْ (صاحب الدعوة الموحدة وحكومته المتوفى 525هـ/1131م)”.
ثم وثّق المقريزي لوضع المدارس الفقهية في عصره، حيث تم ترسيخ وجود المدارس السُنية الأربعة في الحياة العلمية -مع كافة الجوانب المتعلقة بها من وقفيات ومنح دراسية وتعليمية– منذ ظهور دولة المماليك، وأصبحت تتمثل في الهيئات الإدارية والتعليمية محتكرة مناصب السلطة الدينية الكبيرة مثل القضاء والفتوى والخطابة والتدريس، وحتى احتكروا مبدأ التقليد الفقهي رافضين صحة اتباع المذاهب الأخرى!!
وعن ذلك يقول المقريزي: “وعندما أخذ السلطان الظاهر بَيْبَرْس البُنْدُقْداري مسؤولية مصر والقاهرة عيّن أربعة قضاة، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي. واستمر ذلك من سنة خمس وستين وستمئة (665هـ/1270م) حتى لم يبق في مجموع الأمصار الإسلامية مدرسة تُعرف بأطروحات أتبا لها سوى هذه المدارس الأربعة، وعقيدة الأشعري. وأقيمت لأتباعها مدارس وحمامات (= الأضرحة) والأوقاف والمعابد في جميع أنحاء الدول الإسلامية، وعوّد من تمضي مذهب غيرها وأُنكر عليه، ولم يُعَيِّن قاضٍ ولا قُبلت شهادة أحد ولا أُعْطي منصب الخطابة والإمامة والتدريس لأحد إلا إذا كان مقلدًا لإحدى هذه المدارس، وأفتى فقهاء هذه المناطق -خلال هذه الفترة- بضرورة اتباع هذه المدارس وحرمان غيرها، والتمسك بذلك إلى اليوم”!!
ويظل السؤال قائمًا عن الموقف الفكري والمعرفي للمقريزي نفسه، مما يدفعنا للاسْتِعانة بمدرسته الوسطية المعاصرة التي ظهرت بعد قرون من تأسيس المدارس.
الفقه الشرعي المذهبي تلاه ظهور المدرسة السلفية الإصلاحية التيمية، كانت تحاول أن تكون وسيطة بين التشتت الفكري والمدارس الفقهية السنية.
يبدو أن المقريزي كان يميل نحو هذه النهج المعتدل؛ إذ وجد نفسه في وسط تصارع المذاهب الدينية، والحركة الإصلاحية السلفية، لذا تجاوز إلى هذا الموقف الوسطي بعد دراسة عميقة لأسباب الانقسامات بين المسلمين، وصاغ ذلك بمفهوم “التطرف” في التقديرات الفكرية والشخصية؛ فقال في إحدى تصريحاته السلفية والتصحيحية لظاهرة تفرق الجماعات الدينية في الأمة الإسلامية:
“أصل كل تيار بدعي في الدين الانحراف عن أقوال السلف وتفريق عقيدة المسلمين، حتى بلغ المعتزلة في القدر حدًّا أن جعلوا العبد مبدعا لأعماله، وبلغ المجبري في التقدير حدًّا أن خلع عنه الإرادة والاختيار، وبلغ المعطل في نقيض ذلك حدًّا أن أزال عن الله تعالى سمات العظمة وصفات الكمال، وبلغ المتشابه بين الله والبشر حدًّا أن جعله متشابهًا بالناس، وبلغ المرجئ في إلغاء العقوبة، وبلغ المعتزل في مؤاخذة الخلود في العذاب، وبلغ الناصبي في نفي حق علي بن أبي طالب عن الإمامة، وبلغت الفئات المتشددة حدًّا أن جعلوه إلهًا، وبلغ المتأنق في التمييز لأبي بكر رضي الله عنه، وبلغ الشيعة في تأخيره حتى أكفَروه!
وساحة الشك واسعة والأفكار الوهمية قائمة، فاصطدمت الظنون وتراكمت الأوهام، وصدى كل فريق في الشر والعناد والانحراف والفساد وصل إلى ذروة غايةٍ وأقصى حدّ، وتعاقدوا وشتموا واستيلوا الأموال وأماروا الدماء، وظهروا بالقوى ودعموا بالحكام، لو كان أحدهم إذا زاد في أمره خلاف الآخر قريب منه، فإن الظن لن يبتعد كثيرًا عن الظن ولن ينتهي بالمنازعة إلى الطرف الآخر من الطرفين، ولكنهم رفضوا إلا ما ذكرنا من التعاقب والتداخل، ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾؛ (سورة هود/الآية: 118-119)”.

الاهتمام القبطي
من أبرز النقاط التاريخية التي جذبت انتباه المقريزي وأولى لها الاستقصاء الفكري، سواء في تاريخ مصر أو تاريخ التفكير؛ هو التقدير البارز الذي أبداه للأقباط وتاريخهم، وهذا الاهتمام المميز الذي خصصه للأقباط وتاريخهم، وهو اهتمام مميز قد يُفسر كثرة وعمقه نظرًا لأنه ينطلق من مفهوم عظيم عندهم وينطبق على جميعهم، فهو يقول “قبط مصر خير الأجانب كلها وأحسنهم معاملاً، وأكرمهم نسبًا، وأودعهم رحمةً بالعرب عمومًا”، على ما جاء في كتاب “المواعظ والاعتبار”.
وبالتالي، كتاباته عن تاريخهم تبرز بالاستقصاء العلمي كما كان عرفًا في تاريخ الفكر والعقائد؛ فقد أضاف فصلا إضافيًا (63 صفحة) كان ختامه لموسوعته الغنية “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار”، حيث خصصه لـ”ذكر قبط مصر ودياناتهم القديمة، وكيف تحولوا من التمرد إلى [أتباع] العهد للمسلمين، والقصص والأخبار المتعلقة بهذا، والذكر الوثيق عن كنائسهم وأديرهم، وجذور بداياتهم ومستقبلهم”.
والحقيقة أن ما كتبه المقريزي عن الأقباط يدل على رصانته في الفهم الدقيق للعقائد المسيحية – وبالمثل اليهودية – بشكل يمكننا من استيعاب تصريح الإمام السخاوي عنه ضمن تأريخه، وهو أنه كان يمتلك “معرفة بديانة «أهل الكتاب»، بحيث كان يلتمس الأفضل منهم للاستفادة”، مما يعني أن لديه تلامذة مسيحيين ويهود رجعوا إليه كمرجع في تاريخ دياناتهم؛ ولا عجب إذا كان من بين كتبه كتاب “«شارع النجاة» الذي يضم كل ما تختلف فيه البشر من جذور دياناتهم وفروعها، مع عرض حججها وتحديد الحق من بينها”؛ حسب تصريح الإمام السخاوي.
وفي كتابات المقريزي عن الأقباط؛ نواجه من جديد أسلوبه المعتاد في جمع المعلومات وتنظيمها واختيارها من بين التشتت، والذي يثير فضول القارئ بالأسباب التاريخية، ويزوّد القارئ بفهم لكيفية تطور الأحداث وظهورها؛ لأن “التاريخ الجامع لا يرفض إلا في حادث عظيم تجتاح ذاكرة السامعين”!
انبعثت منها مصر وانبعث منها القبط، وهو ديني نبوي، وهذا يعني أن المصر الحاضرة متصلة بالمصر الماضية، وأن الساكنين في منطقة “المحروسة” يوحدهم نسب روحي عميق.
وبالتالي، لم يفارق المقريزي هذا المنهج عندما قال: “اعلم أن جميع أهل الشرائع -أتباع الأنبياء عليهم السلام من المسلمين واليهود والنصارى- قد اتفقوا على أن نوحا عليه السلام هو الأب الثاني للبشر…، فليس أحد من بني آدم إلا وهو من أولاد نوح”، معتبرًا أن أحفاد نوح تتمركز في ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث، ومن حام بن نوح ينحدر أربعة أولاد أحدهم يُدعى “مصرايم” و”القبط يرتبط بقبطيم ابن مصرايم”.
وإذا كان المقريزي يرى أنه من الصعب الحديث عن نسب نقي يجمع الأقباط لأن “أنسابهم متنوعة ويصعب تمييز القبطي من الحبشي من النوبي من الإسرائيلي (= اليهودي) الأصل من غيره”؛ فقد جعل ذلك ربما تحكم في اعتباره الهوية الثقافية القيمية -حيث يتجلى الدينُ كمجسِّد أعلى للإنسان- هو الرابط بين المسلم والمسيحي، وبالتالي يمثل الذاكرة المشتركة والروابط بين جميع مواطنيه المصريين. وربما بذلك يساعد في إيجاد حلاً لمسألة الأجنبي والأصيل من الأعراق التي لا تزال تشكل جدلا داخل الثقافة المصرية، حيث يفضل بعض المثقفين الأقباط تقديم أنفسهم باعتبارهم حراس الإرث لحضارة الفراعنة.
وفيما يتعلق بلحظة التواصل بين أهل مصر (الأقباط) والإسلام؛ فقد ذكر المقريزي أن المسلمين عندما دخلوا أرض مصر وقد كانوا فاتحين، وجدوا سكانها مقسمين: “«أهل الدولة» وكانوا جميعًا رومًا من جند صاحب القسطنطينية ملك الروم (= الدولة البيزنطية)، واعتنقوا ديانتهم بأجمعهم «ديانة المَلَكية» (= المسيحية الأرثوذكسية البيزنطية)، وكان عددهم يفوق ثلاث مائة ألف رومي. أما الجزء الآخر في الغالب “أهل مصر”، ويُطلق عليهم القبط.. وكلهم «يعاقبة»”، أي أتباع المذهب القبطي المصري الذي ينتمون إلى ما يُسمى اليوم “الأرثوذكسية المشرقية”، وهؤلاء «اليعاقبة» هم “بالحقيقة أهل مصر من الأعلى والأسفل”.
ووفقًا للافتات من المقريزي؛ فإن قتال المسلمين عند دخولهم مصر كان مع الحامية الرومية فقط، وقد “طلب القبط من عمرو [بن العاص] التوصل إلى اتفاق بشأن الجزية وقام بالتوصل لاتفاق عليها، وأقرهم بما يمتلكون من الأراضي وغيرها، وأصبحوا عونًا للمسلمين ضد الروم حتى هزمهم الله تعالى وطردهم من أرض مصر”.
ونتج عن فتح الأقباط للبلاد إحياء وتجديد المذهب اليعقوبي المصري المقرب من الزوال؛ فقد “كتب عمرو لبنيامين (= بينيامين الأول بابا الإسكندرية المتوفى 41 هـ / 662 م) بمثابة بطريرك اليعاقبة بأمان في سنة عشرين من الهجرة (= 20 هـ / 642 م)، واستقبله، وتولى مقعده البطريركي بعد غياب دام ثلاث عشرة سنة، منها عشر سنوات في عهد الفرس لمصر، وبقية الوقت بعد وصول هرقل (= فلافيوس أغسطس الإمبراطور البيزنطي المتوفى 20 هـ / 641 م) إلى مصر، وسيطر اليعاقبة على كنائس مصر وأديرتها (= أديرتها) بأكملها، وحصرت تحت سلطتها بدون المسيحية البيزنطية”.
وربما تكون هذه الجهود في إحياء وتجديد كنائس وأديرة مصر بواسطة الفاتحين المسلمين هي التي أنقذت المذهب الأرثوذكسي المصري من الزوال، وقدمت نموذجًا شرعيًا وفقهيًا اقتدى به فيما بعد علماء المسلمين وحكامهم؛ حيث يبدو أن موقف عمرو بن العاص هذا من المؤسسة الدينية القبطية هو ما جعل الإمامين الليث بن سعد وعبd الله بن لَهيعة (ت 174 هـ / 790 م) يُصدرون فتوى بجواز إعادة بناء بعض الكنائس التي تم هدمها في عهد الخلفاء العباسيين سنة 169 هـ / 786 م، و”قالا: إنها (= بناء الكنائس) جزء من هيكل الدولة، واستشهدا بأن كنائس مصر لم تُبنَ إلا في عصر الإسلام منذ زمن الصحابة والتابعين”.
كان المقريزي حين ينقل بعض التفاصيل المؤلمة والحوادث الأليمة التي تلطخت تاريخ التعايش الديني في مصر، ومن الواضح -من خلال تسجيلاته- أنه يميز بين علاقة المسلمين بالأقباط في مرحلتين: الأولى في الفترة من الفتح إلى قبل عهد الخليفة المأمون العباسي (ت 218 هـ / 833 م)، والتي شهدت زيادة في التمردات والصراعات المسلحة بين الجانبين نتيجة بعض الظروف السياسية والاقتصادية.
والمرحلة الثانية هي: المرحلة بعد الخليفة المأمون الذي انهى حقبة الثورات القبطية بالإجراءات التي اتخذها خلال زيارته التفقدية لمصر سنة 216 هـ / 831 م، مما دفع بدء حقبة جديدة في مصر تميزت بشكل عام بطابع التعايش السلمي، على الرغم من الفتن الطائفية التي استمرت عبر العصور نتيجة للتعصب الطائفي لدى بعض من أتباع الطرفين، بالإضافة إلى التدابير الظالمة التي اتخذها رجال السلطة بما في ذلك تلك الذين وصفهم المقريزي -في كتابه ‘السلوك’- بأنهم “ظلمة الكُتاب الأقباط والمتطاولين”.
وعلى الرغم من تلك الفتن الطائفية، إلا أن المظالم العامة نتيجة للفساد والاستبداد كانت جهاد جيد لتوحيد الرأي العام في المجتمع المصري المسلم والمسيحي. وعلى
على سبيل المثال، وبحسب الواقع كما ورد في ‘اتّعاظ الحُنفا‘؛ يروي المقريزي نفسه أنه في عام 363هـ/974م، قاد أبو محمود إبراهيم بن جعفر البربري الكُتَامي (ت 370هـ/981م) -الجنرال الفاطمي- جيشه إلى دمشق وهي تعصف بالفوضى والاضطراب، حيث بادر أهل المدينة -بقيادة “شيوخها” – بتنظيم مسيرات سلمية تستنكر الاضطراب وتطالب بتأمين الأمن. وفي تلك الانتفاضات السياسية الهادئة، قام المسلمون بفتح المصاحف، والمسيحيون بفتح الإنجيل، واليهود بفتح التوراة، وتجمع الجميع في الجامع حيث صاحوا بالدعاء وطافوا بالمدينة وهم محملون بالمطالب!!
وقد رصد المقريزي -بشكل شبه فريد- لقطات من التواصل والتلاحم بين سكان مصر (سواء مسلمين أو مسيحيين) في المناسبات الدينية والاجتماعية، خاصة خلال احتفالات “عيد الميلاد” و”الشعانين” وغيرها من الأعياد المسيحية التي تحولت فعليًا إلى مناسبات اجتماعية عامة تجمع جميع السكان، على الرغم من الملاحظات الشرعية التي تطرحها العلماء.
وقد سرد المقريزي تفاصيل متنوعة عن هذه الاحتفالات المسيحية في مختلف فترات تاريخ مصر السياسي، وتحدث بشكل خاص عن الطقوس المرافقة لاحتفالات «ليلة الغطاس» -والتي تحتفل في يناير/كانون الثاني من كل عام- في عهدي الإخشيديين والفاطميين. ونقل شهادة المؤرخ المسعودي (ت 346هـ/957م) عن إحدى زياراته ووقائعها قائلًا:
“ليلة الغطاس بمصر من الفعاليات المهمة لأهلها، حيث لا يغفو الناس فيها…؛ كنت حاضرًا في ليلة الغطاس بمصر في سنة ثلاثين وثلاثمئة (330هـ/942م)، وكان الأمير المعروف محمد بن طُغُج الإخشيدي (ت 334هـ/955م) يحضر الاحتفالات في مقره بـ«المختار» بالجزيرة الواقعة في النيل، وكان النيل مزينًا بالمراكب. وكان أُمِرَ بإشعال الآلاف من الشموع على ضفاف النهر، بالإضافة إلى الأضواء التي كان أهل مصر ينشرونها من خلال المشاعل والشموع، وحضر آلاف المسلمين والمسيحيين إلى شواطئ النيل في تلك الليلة، كان بعضهم على متن القوارب، وكان آخرون على ضفاف النهر، وكان آخرون على الطرقات. وكانت المأكولات والمشروبات والمجوهرات والملاهي والعزف والألعاب الصاخبة لم تنقطع. هذه الليلة كانت أفضل السهرات في مصر، وأكثرها فرحًا، دون إغلاق للشوارع!”
قد يعجبك ايضا
تراث
أقرأ أيضا
© 2025 Al Arabiya Now • Built by Awtad Space







